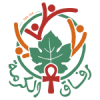حين يصير بنيان الجماعة طريقًا للعمل بمشيئة الله
بقلم الأب داني يونس اليسوعي
معايير لاكتشاف مشيئة الله؟
هذا المقال هو الثالث في سلسلة من المقالات الّتي من خلالها نسعى إلى التفكير في معايير تمييز صالحٍ لأيّامنا الحاضرة. مسيرة التمييز الإغناطيّ تتطلّب معرفة للذات تزداد عمقًا مع الزمن بحيث أتعلّم بالخبرة ما الّذي يقودني إلى النموّ والفرح – أي إلى مشيئة الله – ، وما يقودني إلى طريق مسدود يدفعني إلى الحزن والقلق. وهذه المسيرة تكشف لي عن دعوة يسوع المسيح لي لأشاركه في رسالته في المكان الّذي أنا فيه، فأتبنّى نظرته إلى العالم بحيث يصير واقعي العاديّ واليوميّ هو مادّة صلاتي ومكان رسالتي والوزنة الّتي عليها ائتمنني الله. أريد إذًا أن تكون قرارات حياتي متّجهة نحو الله[1]
وأعرف أنّ هذا يتطلّب بحثًا لأنّ إرادة الله ليست إجابات جاهزة وفروض محدّدة، بل هي تتجسّد في الواقع الّذي أعيش فيه. ويساعدني في بحثي ما اصطلحنا على تسميته "الوسائل الإغناطيّة" مثل التأمّل اليوميّ ومراجعة الحياة، بهدف النموّ في أن نجد الله في كلّ ما نفعله. ولكن هنا تبرز الحاجة إلى معايير هدفها أن تذكّر غاية التمييز وروحه، وأن تلفت النظر إلى بعض النواحي الّتي قد ننساها في مراجعة حياتنا، وأن تعطي اتّجاهات لبحثنا عن مشيئة الله. ليست هي تمييز "جاهز للاستعمال" ولا تغني كلّ واحد منّا عن أن يقوم بمسيرته الشخصيّة، لكنّها قد تغني هذه المسيرة وتخدمها.
في المقال الأوّل ميّزنا بين "دعوتين" نسمعهما في أعماقنا، إحداهما تقودنا إلى توجيه طاقاتنا بحسب منطق الفعاليّة المباشرة، "الإنجاز"، البحث عن النجاح، والأخرى تقودنا بحسب منطق الخصوبة إلى حمل الثمار من خلال قبول الأوقات المختلفة: زمن الزراعة، وزمن النموّ البطيء، وزمن الحصاد. في أيّ صوت من الصوتين نسمع صوت الله؟ في أيّة دعوة نجد مشيئة الله؟ المقال الثاني يسعى إلى التفكير في فتور الهمّة في الرسالة: ماذا يحصل حين يصيبنا الملل في حياتنا الروحيّة، خصوصًا في الرسالة، وكيف نتصرّف في تلك الأوقات؟ كيف نجد الله ونعمل مشيئته في زمن الاضطراب والأزمات؟ والآن نطرح معيارًا جديدًا للبحث عن مشيئة الله: بنيان الجماعة. على أيّ أساس نقول أنّ إرادة الله في حياتنا تتحقّق حين نسير في اتّجاه ما ينمي الجماعة ويبنيها ويغذّيها؟
"أصدقاء في الربّ"
في أيّام القدّيس إغناطيوس نشأت جماعتان على الأقلّ تعيشان بحسب نهج[2] التمييز الروحيّ الإغناطيّ: جماعة بدأت علمانيّة ثمّ تحوّلت إلى مجموعة كهنة، ثمّ صارت رهبانيّة "رفاق يسوع" (الرهبانيّة اليسوعيّة)، وجماعة علمانيّة نشأت حول اليسوعيّن الأوائل وصارت شيئًا فشيئًا "جماعة الحياة المسيحيّة" (رفاق الكرمة). المسيرة الّتي قام بها الأشخاص الّذين ينتمون إلى هاتين الجماعتين تظهر بوضوح كيف يدفعنا النهج الإغناطيّ2 إلى اكتشاف قيمة بنيان الجماعة معيارًا للمسير بحسب مشيئة الربّ.
ألقى إغناطيوس الرياضات الروحيّة على زملاء له في جامعة باريس، فاختار البعض منهم أن يكرّس حياته لخدمة الربّ، لكن لا بهذه الطريقة أو تلك، بل على حسب ما تكشفه لهم إرادة الله وكما يرسلهم الربّ. أرادوا أن يعيشوا حجّاجًا على دروب الناس، يكلّمونهم عن الربّ ويدفعونهم إلى حبّه وخدمته. لذلك اجتمعوا وقرّروا أن يذهبوا إلى القدس إن سنحت الفرصة، لكي يتكرّسوا للربّ في الأرض الّتي كرّسها الربّ. وإن لم يستطيعوا، يضعون أنفسهم في تصرّف السلطة الكنسيّة لكي ترسلهم إلى حيث ترى أنّ فيه فائدة أكبر لخدمة الملكوت. وبما أنّ الظروف قد تعيق مشاريعنا لكنّها لا تعيق خصوبة عمل الربّ فينا، لم يستطع الرفاق الذهاب إلى القدس فقرّروا الذهاب إلى روما. لكن قبل مقابلة أسقف روما طرحوا على أنفسهم سؤالاً لم يحسبوا له حسابًا سابقًا: هل يقدّمون ذواتهم إلى قداسة البابا رجالاً يريدون أن يضعوا أنفسهم في تصرّفه؟ أم جماعة وجسدًا رسوليًّا؟ وبعد مسيرة تمييز أخذت أيّامًا من الصلاة والمناقشة والانتباه إلى حركات النفس الداخليّة من انبساط وانقباض، وصلوا إلى الصيغة التالية: "بما أنّ الربّ الرؤوف والرحيم قد ارتضى بأن يجمعنا وأن يوحّدنا، نحن الضعفاء والآتين من مناطق وثقافات مختلفة جدًّا، ارتأينا ألاّ نفرّق ما جمعه الله ووحّده، بل نثبّته ونمتّنه أكثر فأكثر بأن نجتمع في جسد واحد." هذه "الصداقة في الربّ" الّتي جمعت الرفاق في جسد رسوليّ أظهرت خصوبتها سريعًا: فخطابات القدّيس فرنسيس خافيير الملتهبة تصل من الهند البعيدة وتلهب صدور الرفاق الجدد في أوروبا بكاملها، وهموم الإرساليّات في العالم الجديد تصير هموم العاملين في المدارس وخادمي قصور الملوك. وقد أصرّ إغناطيوس على استخدام وسائل الاتّصال – الرسائل – بكثافة ليحافظ على وحدة الجسد الموزّع في العالم كلّه، وقد دفع ثمن إصراره إذ كتب أكثر من ستّة آلاف رسالة حين كان رئيسًا عامًّا على الرهبانيّة الفتيّة.
هي الصداقة في الربّ ذاتها الّتي أوحت إلى جماعات الحياة المسيحيّة أن يجتمعوا في رابطة عالميّة، وفي منتصف القرن العشرين قاموا بخطوة جبّارة، وهي الانتقال من فكرة الرابطة إلى فكرة الجماعة العالميّة، وما زال تيّار الروح يقود هذه الجماعة لتتحوّل من جماعة أشخاص مرسلين إلى جسد رسوليّ، أي لكي تحمل علاقات الأعضاء بعضهم بالبعض الآخر كلّ ثمار الروح المنتظرة. فالفرق بين الرابطة والجماعة العالميّة هو كالفرق بين التعاون والتضامن: في التعاون والتنسيق غنى كبير، أمّا في التضامن فهناك وحدة مصير وهمّ مشترك. في الرابطة ديموقراطيّة الأكثريّة وميزان الحقوق والواجبات، وفي الجسد حركات الروح من تعزية وانقباض وبحث عن مشيئة الله. والفرق بين جماعة من الأشخاص المرسلين وبين جماعة مرسلة هو كالفرق بين مدرسة وعائلة: في المدرسة يتكوّن الإنسان ويتعلّم أن يختار، وينطلق كلّ في رسالته، أمّا في العائلة، حيث يجد كلّ شخص طريقه أيضًا، يبقى أنّ قرار الآخر يخصّ الجسد بأكمله والجسد بأكمله يسند كلّ عضو من أعضائه، وتكون حياة الجسد ونموّه وحفاظه على اندفاعه الرسوليّ "لمجد الله الأعظم" وبحثه عن مشيئة الله، همًّا مشتركًا للأعضاء كافّة ومعيارًا لتمييزهم. هذا ما تحتوي عليه الأفعال الأربعة: التمييز والإرسال والمساندة والتقييم الّتي تعبّر بحسب نصوص رفاق الكرمة الأخيرة عن هويّة الجسد الرسوليّ الّذي يريد الرفاق أن يضعوه بتصرّف الربّ في الكنيسة.
في البدء كانت العلاقة
إنّ المتخصّصين في الروحانيّة الإغناطيّة يعلمون أنّ مثال النهج الإغناطيّ هو في حياة الرسل: كما جمع يسوع الرسل ليرافقونه فيرسلهم يبشّرون (مرقس 3: 14)، كذلك أراد أن يكون اليسوعيّون (وكلّ جسد يتبع هذا النهج): رفاقًا للربّ يرسلهم حيث يريد. لكنّنا بعيدون جدًّا عن منطق "الموظّفين"[3]، فالربّ أراد أن يبني الرسل ليكونوا "جسده"، يحبّهم إلى أقصى حدّ (يوحنّا 13: 1، و15: 13) ويكشف لهم عن ذاته وعن مشيئة الآب (يوحنّا 15: 15 الخ...)، وهم يطلبونه فوق كلّ شيء (فيليبي 3: 8). إنّ علاقة الصداقة والمحبّة الّتي تربط يسوع بالرسل هي الّتي تحمل الثمار لتغذّي العالم كلّه. "إنّ حبّة الحنطة الّتي تقع في الأرض إن لم تمت تبقَ وحدها، يقول الربّ، وإن ماتت أتت بثمار كثيرة" (يوحنّا 12: 24). في إنجيل مرقس يظهر دور الرسل بوضوح: متى يبدأ يسوع بإعلان أنّه سيموت ثمّ يقوم من بين الأموات؟ مباشرة بعد أن اعترف به التلاميذ في قيصريّة فيليبس أنّه هو المسيح (مرقس 8: 27-33). منذ تلك اللحظة لم يعد يسوع "يجول" في الجليل بين القرى، بل أخذ طريق أورشليم بدون رجعة. لأنّ "النار الّتي أتى يشعلها" بدأت عملها في الرسل. بإمكانه الآن أن "يخلي ذاته حتّى الموت، موت الصليب" (فيليبي 2: 6-11). نعم الكنيسة ليست مجرّد وسيلة لرسالة المسيح، بل هي "جسده"، لهذا هو يبنيها بالإفخارستيّا. فالعلاقة الشخصيّة بين المسيحيّ ويسوع هي الّتي تُخصب الرسالة، لأنّ علاقة الصداقة والمحبّة تكشف عن الله أكثر من الكلام. كذلك علاقة المسيحيّين في ما بينهم وعلاقتهم بالبشر عامّة. والعلاقة ليست مسألة "إنجاز"، بل تتطلّب وقتًا وبذلاً للذات، صبرًا وثقةً بأنّ ما يُزرع بالدموع سيُحصد بالفرح كما يقول المزمور 126 (125).
يتّضح لنا هكذا لماذا الله يعمل لخلاص العالم عن طريق اختيار أشخاص محدّدين: إبراهيم، إسحق، يعقوب، موسى والشعب العبرانيّ... لا لأنّ عنده أفضليّات، بل لأنّه يريد أن يخلّص العالم من خلال العلاقة في ما بينهم. فعلى المختار أن يعلم أنّه ليس أفضل من غيره ويسعى لأن "يفرغ ذاته" (كما فعل المسيح) لكي "يتبارك به جميع أمم الأرض" (تكوين 12: 3). ولا يخفى علينا لماذا يريد الربّ خلاص العالم من خلال العلاقة، فالله علاقة في ذاته. هذا ما يقوله لنا إيماننا الثالوثيّ: في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت لدى الله، والكلمة كانت هي الله. ومن يقول "الكلمة" يقول "العلاقة"، علاقة متكلّمين، أي علاقة حرّة. في البدء كانت العلاقة في قلب الله، والله يقود الإنسان ليدخل في هذه العلاقة بكلّ حرّيّة: "ليكون لكم شركة معنا، وشركتنا مع الآب وابنه يسوع المسيح، فيكون فرحنا تامًّا" (1يوحنّا 1: 3-4)
بنيان الجسد
إنّ التفكير في سرّ الكنيسة على أنّها "جسد" ينبغي له أن ينمو، يشكّل ركنًا مهمًّا من تعليم بولس الرسول. فهو يستخدم صورة الجسد في أماكن عديدة: مثلاً في رسالته إلى أهل روما الفصل 12، الآيات 4-8 وفي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل 12، الآيات 12-30، وكذلك في أفسس 4: 11-17. خلاصة كلامه أنّ تعدّد مواهبنا وشخصيّاتنا لا تشكّل عائقًا أمام وحدتنا، بل على العكس، تنوّعنا هو شرط نموّ الجسد. "فلو كان الجسد كلّه عينًا أين السمع؟ ولو كان كلّه أذنًا، أين الشمّ؟ ... فلا تقدر العين أن تقول لليد: "لا أحتاج إليك" ولا الرأس للرجلين: "لا أحتاج إليكما" " (1كو 12: 17 و 21). لكنّ القدّيس بولس لا يكتفي بعرض هذه الفكرة داعيًا إيّانا إلى قبول اختلافاتنا واستخدامها في سبيل حياة الجسد، بل هو يذهب إلى أبعد ويجعل من بنيان الجسد معيارًا لخبرتنا الروحيّة. تنوّع المواهب الروحيّة مهمّ وقد أظهر بولس أهمّيّته في الفصل 12 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس داعيًا المؤمنين إلى أن يطمحوا إلى المواهب (12: 31). وفي الفصل 13 يذكر ما يتخطّى كلّ المواهب، أي المحبّة الّتي بدونها لا قيمة للمواهب مهما عظمت. في 1 كورنثوس 14 يعالج الرسول مسألة مهمّة: ليست لكلّ المواهب القيمة نفسها: "من يتكلّم بلغات يبني نفسه، وأمّا الّذي يتنبّأ فيبني الكنيسة" (14: 4)، "فاطلبوا أن يزيدكم الله من المواهب لبنيان الكنيسة" (14: 12)، "أفضّل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلّم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات" (14: 19). فالمواهب ليست غاية بذاتها، وكذلك السعي وراء المواهب بدون المحبّة يجعلني"نحاس يطنّ أو صنج يرنّ" (13: 1). يسلّمنا هنا القدّيس بولس مفتاحًا أساسيًّا للتمييز يختصره بكلمة: "فليكن كلّ شيء للبنيان" (1كو 14: 26). ما يبني الجسد يصير معيارًا لما يجب أن أطلبه وأسعى إليه، أي في مسيرة تمييزي الروحيّ[4]. فلنحاول الآن أن نستخرج من هذا المعيار "منطقًا" يوجّه تمييزنا اليوميّ. سنقوم بذلك من خلال سؤالين: ما هي المواقف والعادات الّتي تدعوني صورة الجسد إلى تنميتها في شخصيّتي؟ وما هي المواقف والعادات الّتي يدعوني إلى تجنّبها؟
"اطمحوا إلى المواهب". الجسد طاقة، يُبنى بنموّ أعضائه. لذلك أسعى إلى الاعتراف بمواهبي وتنميتها. لا يهمّ عددها أو أهمّيّتها بنظر العالم. ما يهمّ أنّ الّذي يدخل في منطق بنيان الجسد يسعى إلى قبول ذاته وخصوصًا اكتشاف طاقاته، لأنّها تشكّل في أكثر الأحيان علامة على إرادة الله في حياتي (أي علامة على دوري في الجماعة[5]). لكنّ الجسد هو أيضًا تواصل وعلاقة، بين الأعضاء ومع الآخرين. لذلك يدعوني منطق الانتماء إلى جسد إلى أن أنمّي في نفسي القدرة على التواصل: الإصغاء، التعبير عن الذات، أخذ الآخر بعين الاعتبار واحترام شخصيّته، القدرة على الصداقة، وكلّ المهارات الّتي تعزّز القدرة على إقامة علاقات ناضجة. وكذلك تنمية القدرة على العمل مع آخرين: احترام المواعيد، احترام الأدوار المختلفة، الالتزام والمساعدة المتبادلة. يذكّرنا القدّيس إغناطيوس أنّ المسيحيّ الصالح يسعى بالأَولى إلى تبرير فكرة القريب، لا إلى الحكم عليها (ر.ر. 22). وقد نضيف أيضًا المرح. نختصر هذا الموقف الثاني بكلمة "استقبال": بابي مفتوح، لا يغلقه مزاج عكر ولا خجل مبالغ فيه ولا ثقة بالذات تتخطّى الحدود فتصير تصغيرًا للآخر. والجدير بالذكر أنّ الاستقبال يتضمّن مهارات نتدرّب عليها ونتعلّمها. الموقف الثالث الّذي عليّ تنميته يتعلّق بالجسد على أنّه "تضامن": المشاركة بالهموم الرسوليّة، بالأفراح وبالأحزان، "الشعور مع" الآخر، مع الجماعة، مع المجتمع، لا بمعنى المشاعر السطحيّة بل بما يقتضيه ذلك من التزام وعمل وتجنيد الطاقة للخدمة. إنّ هذا الموقف هو في عمق أعماق عقيدة التجسّد: إنّ ابن الله صار "جسدًا" فتضامن معنا إلى أقصى الحدود. يقول القدّيس غريغوريوس اللاهوتيّ مصلّيًا: "وحّدتَ يا رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، حياتك بموتنا وموتنا بحياتك، أخذتَ ما لنا ووهبتنا ما لك، لتحيينا وتخلّصنا، لكَ المجد إلى الأبد". هذه الصلاة الّتي تكرّرها في كلّ قدّاس الليتورجيا المارونيّة (عند كسر الخبز) صدى لما صنعه المسيح "لأنّه أحبّني" (غلاطية 2: 20)، وهذا ما نختصره بكلمة : "من أجلنا ومن أجل خلاصنا تجسّد". وبتجسّده تضامن معنا فصار كلّ ما هو له لنا وكلّ ما هو لنا له (راجع ر.ر. 204). هذا ما نسمّيه شركة القدّيسين. لهذا فإنّ موقف التضامن هذا يجعل رسالتي مندمجة برسالة المسيح، بل أنا حين أقوم برسالتي، أخدم رسالة المسيح نفسها. إنّ موقف التضامن هذا يدفعني لفهم جسدي على أنّه "حضور": أنا حاضر أي أنا منتبه (مثل مريم في عرس قانا الجليل – يوحنّا 2–)، أنا حاضر أي أنا مستعدّ، أنا حاضر أي أنّي "على مستوى الحدث". وهنا أيضًا ينمو الإنسان في فضيلة الحضور: لكي يستطيع الإنسان أن يكون حاضرًا، وأن يكون "قدّها وقدود"، لا بدّ له أساسًا أن يبذل الوقت. كما في الصلاة. لا يصل الإنسان إلى مستوى حضور عميق أمام الله إلاّ بعد بذل الوقت مع الله، مجّانًا. لا يكسب الإنسان ثقة الطفل إلاّ إن أعطاه وقتًا. وكذلك لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من الذكاء أن يكون حاضرًا لمجتمعه وكنيسته وجماعته إن لم يبذل فيها وقتًا مجّانيًّا. الحضور هو أيضًا "انتفاضة" ضدّ التخاذل والخوف والحزن والانقباض أي كلّ ما يدفعني إلى اللجوء إلى عالم وهميّ أو إلى الهروب في أفكاري الخاصّة وإلى تخيّل الحوارات الوهميّة لكي أخلق عالمًا أكون فيه أنا البطل. الحضور هو الواقعيّة. أنا هنا، ومن هنا أبدأ لكي أخطو خطوات إلى الأمام. ولا أنسى أنّ دراستي وعملي هما طريقان مميّزان لأكون حاضرًا لمجتمعي.
ننتقل الآن إلى المواقف الّتي يعلّمنا منطق الجسد أن نتجنّبها. أوّلاً يحذّرنا منطق الجسد من روح المقارنة والغيرة. إنّ المقارنة مع الآخرين تدخلني في دوّامة من الرغبة في فشل الآخر ومن الشعور بالذنب بسبب ذلك، مّما يبدّد طاقاتي ويرهقني بدون أيّة ثمار. وحيث لا ثمار، نعلم أنّ منطقًا غير منطق الروح يعمل فينا. كيف نجابه هذا الموقف؟ بكلّ بساطة بتنمية المواقف المناقضة، أي تلك الّتي ذكرناها أعلاه. يحذّرنا منطق الجسد أيضًا من المواقف "البطوليّة" حيث لا أريد أن أعتمد على الآخرين، بل أريد أن أعطي بدون أن آخذ، وأضحّي بدون مقابل... فالمحبّة هي قدرة على قبول الآخر الّذي يقبلني وبحبّه يقوّيني وبغفرانه لي يشجّعني وبعتابه يربّيني. قد تنشأ صراعات داخل الجماعة، هذا ممّا لا شكّ فيه. منطق الجسد يحذّرنا من طرق معيّنة في التعامل مع الصراعات: مثلاً أن أسعى إلى "النصر" وإن على حساب خير الجماعة (راجع القصّة الجميلة في 1ملوك 3: 16-28)، أو أن أفقد الثقة بالجماعة وبدعوتها الإلهيّة، أو أن أتجنّب الصراعات وكأنّني غريب عن الجسد، أو أن أحكم على قريبي ناسيًا أنّنا أعضاء بعضنا لبعض. وأخيرًا يدعوني منطق الجسد إلى الابتعاد عن منطق "الشلّة"، أي الجماعة المبنيّة على تلاقي المصالح بين أنانيّات مختلفة، أو تلك الّتي تدعو إلى التماثل: "كن مثلنا أو ارحل عنّا" حيث لا حرّيّة حقيقيّة بل تكتّل ناتج عن الخوف والاحتياج إلى حضن دافئ. جماعات كهذه لا تقدر أن تكون رسوليّة.
بنيان الجماعة: أولويّة رسوليّة
يمكننا أن نستنتج ممّا قلناه حتّى الآن مسائل عمليّة جدًّا. منها مثلاً أهمّيّة الأوقات "الاجتماعيّة" social time ، مثل الرحلات أو فترة الطعام في اللقاءات العامّة، الخ... الّتي ليست وقتًا للاستراحة من الرسالة، بل هي رسالة بحدّ ذاتها على قدر ما هي بنّاءة لحياة الجماعة. وربّما تستدعي أهمّيّتها أن تُحضّر جيّدًا مع وسائل تدمج الناس معًا وتمتّن الصداقات. منها أيضًا السهر، في النشاطات الرسوليّة من نوع "معرض بلدي"، على أن تبقى الرسالة، رسالة الجسد، أي أن تنمّي العلاقات بين الناس وأن ننتبه إلى دخول هذا النشاط في حياة الأعضاء وصلاتهم، وربّما أيضًا نسعى إلى فهم ارتباطه العميق بهويّتنا: لماذا يدعونا الربّ اليوم إلى هذه الرسالة؟ لسنا رسلاً أقلّ حين نهتمّ بتمتين علاقات الأعضاء ببعض، بشرط أن ينمو الجسد في دعوته الرسوليّة وألاّ يتحوّل إلى "شلّة" محترمة ذات مستوى، لها لغتها الخاصّة وتريد أن تميّز نفسها على قدر الإمكان عن الآخرين.
الانتماء عمليّة مستمرّة لا تنتهي
إنّ انتماءنا إلى جماعة إيمان عمليّة ديناميّة، أي أنّ الانتماء هذا ينمو فينا وننمو فيه على قدر ما "ننخرط" في الجسد، على قدر ما "نتورّط" فيه، أي على قدر ما تنمو فينا المواقف الإيجابيّة الّتي سبق ذكرها. لسنا "أعضاء" أم "غير أعضاء"، بل نحن نصير يومًا بعد يوم أكثر عضويّة على قدر ما يكون بنيان الجسد معيارًا لقراراتنا يعبّر لنا عن مشيئة الله. وطريق النموّ يمرّ بإخفاقات كثيرة. لهذا لا نجد جسدًا "ملائكيًّا" لا خطأ فيه، بل الخطر أن نسعى إلى جسد كذلك. لسبب بسيط هو أن الملائكة لا جسد لهم. لكن هنيئًا للّذي يقع على الطريق ثمّ يعاود السير، لأنّه سيكتشف أنّ في كلّ الأشياء – بما فيها الوقوع – الله يعمل مع الّذين يحبّونه لما فيه خيرهم (روما 8: 28).
للتأمّل والصلاة والمشاركة
* روما 12: 1-16
** 1كو الفصول 12 إلى 14، خصوصًا 12: 12-30
(في "نصوص روحيّة للرياضات الإغناطيّة" نصّ للقدّيسة تريزيا الطفل يسوع هو تأمّل في هذه النصوص تجده بين نصوص اليوم العاشر من الأسبوع الثاني (2/10)، وهو نصّ جميل.)
*** أعمال الرسل 11: 19-30
كيف نفهم موقف برنابا انطلاقًا من "كلّ ما هو لي هو لك"؟
كيف يظهر جسد الكنيسة في هذا النصّ؟ وكيف يظهر هذا الجسد في حياتنا؟
**** 1 ملوك 3: 4-15 كيف ترتبط العلاقة الشخصيّة جدًّا مع الله بحضور الجماعة في حياتنا؟
[1] "لمجد الله الأعظم" كما كان يقول القدّيس إغناطيوس متّبعًا وصيّة بولس الرسول الّذي كتب يقول: "إن أكلتم وإن شربتم أو مهما فعلتم فافعلوه لمجد الله" 1كو10/31)
[2] نهج يعني طريق وطريقة. بهذه الكلمة نترجم عبارة عزيزة على القدّيس إغناطيوس ورفاقه وعلى اليسوعيّين عامّة: "notre manière de procéder ".
[3] راجع الفرق في الإرسال بين المسيح والعدوّ في تأمّل الرايتين (كتاب الرياضات الروحيّة – ر.ر. – رقم 142 و146
[4] إن مسيرة التمييز في الرياضات الروحيّة تعبر في مراحل مختلفة (الأسابيع الأربعة) باختلاف النعمة الّتي نطلبها، فمسيرة التمييز هي أيضًا نموّ في معرفة النعمة الّتي أحتاج إليها الآن لأنمو ولأبني الجماعة.
[5] لاحظ القارئ النبيه أنّ عبارة "إرادة الله" تحتوي على أبعاد مختلفة (ما يعطيني سعادة وسلام، دوري في الجماعة، ...) وهي كلّها تصبّ في خانة واحدة، هي أن أصير أكثر فأكثر شريكًا لله الّذي ما زال يعمل كلّ شيء في سبيل الإنسان.