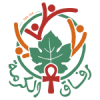بقلم الأب/ جاك ماسون اليسوعي
تلقيت مجموعة من الأسئلة عن الموت والدينونة الأخيرة والسماء وما يقوله الكتاب المقدس عن ذلك كلّه. إن فكرة قيامة الأموات ليست بديهية، وقد يصعب علينا أن نؤمن بها أو نتخيلها. وحين نهى يسوع تلاميذه عن أن يحكوا ما رأوه أثناء تجليه على الجبل إلا "بعد قيامة ابن الإنسان من بين الأموات"، فإن التلاميذ امتثلوا لأمره، بيد أنهم كانوا يتساءلون عما يقصده يسوع بالـ "قيامة بين الأموات" (مر 9/9 - 10). فالإيمان بالقيامة تأخر في الظهور في العهد القديم، فهو لم يظهر إلا في زمن المكابيين، أي حوالى 150 عامًا قبل مجيء يسوع: "إنك أيها المجرم تسلبنا الحياة الدنيا، ولكن ملك العالم، إذا متنا في سبيل شرائعه، سيقيمنا لحياة أبدية" (2 مك 7/9).
***
إذًاً ماذا عن العهد القديم قبل زمن المكابيين؟
لا يعني غياب الإيمان بالقيامة أن اليهود كانوا يظنون أن الموت هو عودة إلى العدم، بل كانوا يؤمنون بنوع من الحياة بعد الموت، حياة في الجحيم. ونرى الملك شاول ذاهبًا إلى امرأة تستحضر الأرواح طالبًا عودة النبي صموئيل من بين الأموات ليستشيره (1 صم 28/3 – 15). لكن هذه الحياة ليست حياة بتمام معنى الكلمة بل هي حياة في التراب! وفي سفر الجامعة نقرأ كلمات الحكيم المسن: "لأن مصير بني البشر هو مصير البهيمة ولها مصير واحد: كما تموت هي يموت هو ولكليهما نفس واحد. فليس الإنسان أفضل من البهيمة لأن كل شيء باطل. كل شيء يذهب إلى مكان واحد كان كل شيء من التراب وكل شيء إلى التراب يعود. من يدري هل نفس بني البشر يصعد إلى العلاء ونفس البهيمة ينزل إلى الأسفل إلى الأرض؟" (جا 3/19 - 21).
فما هي طبيعة هؤلاء الموتى الأحياء؟ إن الساحرة التي استعان بها شاول ترى "إلوهيم" أى آلهة، وفي سفر تكوين تقول الحية: "تصيران كآلهة" (تك 3/5)، وكذلك يقول داوود في مزمور 8 "دونَ الإله حططته قليلاً بالمجد والكرامة كللته" (مز 8/6). ويتحدث سفر الجامعة عن "نفخة" أو "نسمة": "فيعود التراب إلى الأرض حيث كان ويعود النًفًس إلى الله الذي وهبه" (جا 12/7). وكل ذلك مبهم، ولكن الشيء المؤكد هو الإيمان بأن الموتى أحياء ولكن لهم حياة بائسة جدًا: "فليُلاحق العدُّو نفسي ويُدركها وليطأ في الأرض حياتي وليُسكن في التراب مجدي" (مز 7/6 وراجع أيضاً مز 88/11 - 13)، وكذلك "فإن مثوى الأموات لا يحمدُك والموت لا يُسبٍحُك والذين يهبطون إلى الجب لا يرجون أمانتك" (أش 38/18).
إن الإيمان بعدالة الله هو الذي قاد المؤمنين إلى التفكير في قيامة الأموات، فالعقل لا يقبل أن الله يترك البار (أيوب) يتألم والشرير يسمن وينجح (مز 73)، فلابد أن يكون الله عادلاً وحيث أن العدل ليس من هذا العالم فلابد أنه سيتحقق في عالم آخر. واستشهاد اليهود الملتزمين بالشريعة في عهد الملك أبيفانيوس الأنطاكي كان بمثابة الشرارة التي ولدت الإيمان بقيامة هؤلاء المؤمنين.
ولكن حتى في زمن يسوع، كان الإيمان بالقيامة مثارًا للجدل بين الفريسيين الذين كانوا يؤمنون بها والصديقيون الذين لم يكونوا يؤمنون بها (متى 22/32) ويلوم يسوع الصديقيين قائلاً: "ألم تقرأوا الكتب؟" (متى 22/31)، فالإيمان بالقيامة لا يتأسس على قيامة يسوع فحسب، بل اليهود - على الأقل الفريسيون منهم - كانوا يؤمنون بها قبل مجيء يسوع.
ولكن ما معنى القيامة عند هؤلاء اليهود؟ فالنبي دانيال يكتب: "وكثيرٌ من الراقدين في أرض التراب يستيقظون، بعضهم للحياة الأبدية، وبعضهم للعار والرَّذل الأبدي. ويُضيءُ العُقلاءُ كضياءِ الجلَد، والذين جعلوا كثيرًا من الناس أبرارًا كالكواكب أبد الدهور" (دا 12/2 - 3).
ولكن الغريب أن سفر المكابيين يستبعد الأشرار من القيامة: "ولمَّا فارق هذا الحياة، عذَّبوا الرابع ونكَّلوا به بمثل ذلك" (2 مك 7/13).
ولم يذهب العهد القديم إلى أبعد من مسألة عدالة الله تجاه الأبرار والتي تؤدي إلى القيامة، وهو لا يتناول سوى إشكالية الألم وحدها، ويجد لها حلاً في الخليقة الجديدة، ويتنبأ سفر أشعيا بذلك: "لأني هكذا أَخلُقُ سمواتٍ جديدة وأرضًا جديدة فلا يُذكرُ الماضي ولا يخُطرُ على البال. بل تهللوا وابتهجوا للأبد بما أنا أخلُق فإني هاءنذا أخلُق أورشليم للابتهاج وشعبها للسرور وأبتهج بأورشليم وأُسرُّ بشعبي ولا يُسمع فيها من بعدُ صوت بكاء ولا صوت صراخ. لا يموت هناك من بعدُ طفلُ أيام ولا شيخ لم يستكمل أيامه لأن صغير السن يموت وهو ابن مئةٍ سنة والذي يموت دون مئةٍ سنةٍ فإنه ملعون ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها ويغرسون كرومًا ويأكلون ثمرها. لا يبنون ويسكن آخر ولا يغرسون ويأكل آخر لأن أيام شعبي كأيام الشجر ومختاري يتمتعون بأعمال أيديهم. لا يتعبون باطلاً ولا يلدون للرعب لأنهم ذُرِّيَّة مباركي الرب وسلالتهم معهم. قبل أن يدعو أُجيب وبينما هم يتكلَّمون أستجيب. الذِّئب والحمل يرعيان معاً والأسد كبقرٍ يأكل التبن أما الحيّة فالتراب يكون طعامها لا يسيئون ولا يفسدون في جبل قدسي كله، قال الرب" (أش 65/17 - 25). ويضع العهد القديم القيامة في مركز خليقة جديدة.
***
وما الجديد الذي يأتي به العهد الجديد إلى معتقدات اليهود هذه؟
أولاً وقبل كل شيء يثبت العهد الجديد الإيمان بالقيامة: "فاملأوا أنتم مكيال آبائكم" (متى 23/32)، فالسؤال الذي يطرحه الصديقيون لا يتناول مجرد حياة أخرى في مكان ما، بل يشكك في القيامة! ويفسح رد يسوع مكاناً لأسئلة لا حصر لها عن "متى" ولكننا سنعود إلى مثل هذه الأسئلة لاحقًا.
ويحدد يسوع بعد ذلك "كيف" يقوم الموتى: "بل يكونون مثل الملائكة في السماء" (متى 22/30)، وتقصد بالملائكة أنهم مخلوقات روحية. وسيوضح القديس بولس هذه المسألة ردًا على أسئلة المؤمنين في الأغلب: "وهذا شأن قيامة الأموات: يكون زرع الجسم بفساد والقيامة بغير فساد. يكون زرع الجسم بهوان والقيامة بمجد. يكون زرع الجسم بضعف والقيامة بقوة. يزرع جسم بشريٌّ فيقوم جسمًا روحيًا. وإذا كان هناك جسم بشري، فهناك أيضًا جسم روحي"(1كور 15/42 - 44). ومع ذلك يبقى الأمر مبهماً على الشخص العادي! فما عساه أن يكون هذا الجسد الروحاني؟
ويوسع العهد الجديد - مثله في ذلك مثل العهد القديم - من القيامة لتشمل الخليقة كلها. ونرجع إلى القديس بولس في ذلك أيضًا: "فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلِّي أبناء الله. فقد أُخضعت للباطل، لا طوعًا منها، بل بسلطان الذي أخضعها، ومع ذلك لم تقطع الرجاء، لأنها هي أيضًا ستُحرر من عبودية الفساد لتُشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم" (رو 8/19 - 21). وإن قاربنا بين هذا النص وبين ما قاله يسوع عن القيامة "ستكونون كملائكة" أو أيضاً ما كتبه القديس بولس عن "الجسد الروحاني"، فربما نصل إلى فهم هذه الأرض الجديدة والسماوات الجديدة - على طريقة تيار دي شاردان - كمثل صعود للمادة بواسطة الروح كنوع من تأليه للكون كله. وهي صور ومفاهيم يصعب علينا تخيلها، وكما نعجز عن تصور الله، نعجز أيضًا عن تخيل خليقة روحانية.
إن ما يأتي به الكتاب المقدس يتخطى بمراحل كل ما تصوره السينما كنهاية للجنس البشري بعد كارثة نووية مثلاً، فالكتب المقدسة تضفي بعدًا روحيًا على ما نطلق عليه عادة نهاية العالم وتخرج به بذلك من مجرد ظاهرة مادية محضة.
الجسد والنفس - الحياة الأبدية وقيامة الجسد
إن مفهوم كون الإنسان له نفس وجسد هو تراث مأخوذ عن الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية والتي تعود إلى أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد.
ولم يكن الشعب اليهودي - شأنه شأن سائر الشعوب السامية - يتصور الإنسان هكذا، فالإنسان - بالنسبة إليهم - هو كل لا يتجزأ، وهو جسد وعقل وروح ولكن هذه كلها صفات وأبعاد لكيانه لا يمكن تشييئها.
فالجسد هو ضعفه لأنه مائت. والعقل هو ذكاؤه وحالته النفسية. والروح هي قدرته على معرفة الله وعلى أن يكون له حياة روحية. ولكن عندما يموت الإنسان يموت بكليته؛ فيرقد ويعود إلى التراب. وليحيا ثانية، عليه أن ينتصب واقفًا، فيقوم بكامل كيانه من بين الأموات. ولا يتحدث الكتاب المقدس عن الروح، فهذه الكلمة تترجم بالحياة أو "الذات". "فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟" (مر 8/ 36). وعندما اندمجت الكنيسة في العالم الإغريقي، تبنت مفهوم الفلسفة الإغريقية عن الإنسان من حيث كونه جسد ونفس مع التأكيد على خلود النفس. ولتصحيح فكرة تحقير الإغريق للمادة، والتي جعلتهم يرفضون فكرة قيامة الجسد رفضًا تامًا كما جاء في سفر أعمال الرسل "فما أن سمعوا كلمة قيامة الأموات حتى هزئ بعضهم وقال بعضهم الآخر: "سنستمع لك عن ذلك مرة أخرى" (أع 17/32)، أكدت الكنيسة على هذه الفكرة على ضوء قيامة يسوع المسيح "أنظروا إلى يديَّ ورجليَّ. أنا هو بنفسي. المسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي" (لو 24/39). كان الإغريق يقبلون فكرة الحياة الأبدية ولكن بالنسبة للكنيسة، لم تكن الحياة الأبدية متطابقة مع قيامة الأموات. وتحدد الكنيسة الكاثوليكية في تعليمها الكلاسيكي أن النفس لها حياة أبدية ولكنها تتطلع إلى قيامة الجسد.
ويبقى سؤالان "متى" و"أين"؟
ولنبدأ بـ "أين". أين نذهب بعد الموت؟ وأين نذهب بعد القيامة؟ سنرد قطعًا: "إلى السماء". ولكن ليست السماء سوى "صورة"، ونلاحظ أن يسوع حين يعلمنا كيف نصلي يتحدث عن "السموات" بصيغة الجمع، متبعاً ثقافة عصره. ويكتب القديس بولس أنه صُعد به إلى السماء الثالثة (2 كو 12/2)، إذ كان الأقدمون يتخيلون أن الأرض مركز الكون وأن السموات - كدوائر متحدة المركز - تدور حولها، وتتعلق فيها النجوم والكواكب. وكان الله أعلى من السموات وأبعد من كل ما هو مخلوق، فهو المتعالي عن كل شيء.
ولكن يسوع يتحدث أيضًا عن الفردوس "فقال له: الحق أقول لك: ستكون اليوم معي في الفردوس" (لو 23/43). وكان الفردوس - بالنسبة لفئة من اليهود في زمن يسوع - هو المكان الذي كان الأبرار ينتظرون فيه القيامة. ويشير لوقا إلى المعنى نفسه حين يتحدث عن "حضن إبراهيم" (لو 16/22) ولكن بالنسبة لمجمل التقليد اليهودي، يبقى الجحيم أو مثوى الأموات هو المكان الذي فيه جميع الأموات.
كيف يمكن فهم هذه المصطلحات؟ ليس لله مقر، فالمقر يتطلب وجود فضاء مكاني، والله هو لذي خلق الفضاء والمكان. فالله ليس موجوداً في مكان، لأن تواجده في مكان يعني أن هذا المكان أكبر من الله. وليس تعبير "السماء" سوى صورة، توضح سمو الله وتعاليه فحسب. وأخيرًا، فإن كان بالنسبة ليسوع "في السماء، سنكون كالملائكة" وبالنسبة للقديس بولس "القيامة في جسد روحاني" كما أن الله هو روح، فإن الملائكة والأجساد الروحانية ليس لها مكان كما أن الله ليس له مكان...
إن سماء الله ليست لا فوق ولا تحت. وعلينا أن نمحو هذه الصورة ولكننا نحتفظ بها لنسهل الأمر، لأنه من الصعب أن نفكر أو نتخيل دون صور. وبالرغم من ذلك، فإن هناك خطراً من أن نسعى إلى تشييء ما هو روحي.
المطهر
إن مصطلح المطهر ليس مصطلحًا كتابيًا ولا يستعمل بشكل شمولي في المسيحية. إنه مصطلح نشأ في العصور الوسطى في الغرب المسيحي للإشارة إلى حالة نفوس الموتى الذين ليسوا أهلاً للدخول مباشرة إلى حضرة الله وليس مصيرهم الحتمي جهنم. وتأسس مفهوم المطهر على الصلاة من أجل الأموات وهي ممارسة تقوية نجدها منذ العهد القديم حيث نرى يهوذا المكابي يقدم ذبائح من أجل الموتى للخلاص من خطاياهم (2 مك 12/46). وفي الغرب، لم تعم عقيدة المطهر وتصير جزءاً من الإيمان الشعبي سوى في القرن الثاني عشر، استناداً على أقوال القديس برنار، ثم القديس توما الأكويني. لكن التعليم الرسمي للكنيسة بقى متحفظاً بهذا الخصوص، فمجمع فلورنسا الذي أقيم في عام 1438 لا يتحدث إلا عن الآلام التي تطهر من ماتوا وهم في علاقة محبة مع الله. ولم تعلن عقيدة المطهر كمكان إعلانًا صريحًا إلا في المجمع التردنتيني (1545 - 1563). واليوم، إذ يأخذ الكاثوليك بعين الاعتبار اللبس الناتج عن صعوبة التمثيل المكاني لما يتخطى الحياة، فهم يفضلون اعتبار المطهر حالة أكثر منها مكان. وتلك الممارسة التقوية القديمة ألا وهي طلب قداسات من أجل النفوس المطهرية تبدأ في الانحسار، ومع ذلك فالصلاة من أجل الأموات تبقى تقليدًا راسخًا وحيًا حتى اليوم. ويحتفظ القداس اليومي بالصلاة من أجل الأموات.
ونصل إلى السؤال الأخير: "متى". متى تقوم القيامة؟ متى السماء؟
ونقول بسرعة "عند نهاية العالم". "ويأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات"، هكذا عبر نص قانون الإيمان المصاغ في مجمعي نيقية وخلقيدونية. إنه نص يتأسس على الإصحاح 25 من إنجيل متى وكذلك على عظات عن نهاية الأزمنة في الأناجيل الإزائية الثلاثة في متى 24 ومرقس 13 ولوقا 21. إنها نصوص تؤكدها رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي المكتوبة في السنة 51 قبل أي من الأناجيل الأربعة. "لأن الرب نفسه، عند إعلان الأمر، عند انطلاق صوت رئيس الملائكة والنفخ في بوق الله، سينزل من السماء فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم إننا نحن الأحياء الباقين سنُخطف معهم في الغمام، لملاقاة المسيح في الجو، فنكون هكذا مع الرب دائمًا أبدًا" (1 تس 4/16 - 17). (ونلاحظ في النص السابق أن بولس مازال ملتزماً بالتقليد اليهودي عن نهاية العالم في العصر الانتقالي بين العهدين القديم والجديد، والذي كان شائعاً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، لكن رؤية بولس للقيامة ستتغير بعد ذلك).
وتفترض هذه الرؤية القديمة نهاية مادية للعالم: "ورأيت سماءً جديدةً وأرضًا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا، وللبحر لم يبقَ وجود" (رؤ 21/1)، كما كتب يوحنا رؤيته في بطموس والتي تتم نبوءة أشعياء.
وعلى العكس، فإنجيل القديس يوحنا لا يضم مثل هذه النصوص. وبالنسبة للقديس يوحنا فالتجسد يُدخل الأبدية في الزمن وكأنه يجعل الزمن يتفجر بشكل ما، فقد افتتح يسوع المسيح الملكوت: "من آمن به لا يُدان ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد" (يو 3/18). "من آمن بالابن فله الحياة الأبدية ومن لم يؤمن بالابن لا يرَ الحياة بل يحلُّ عليه غضب الله" (يو 3/36). "الحق الحق أقول لكم: من سمع كلامي وآمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية، ولا يمثل لدى القضاء بل انتشل من الموت إلى الحياة" (يو 5/24). "وما أظهر بعد ما سنصير إليه. نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه لأننا سنراه كما هو" (1 يو3/2). وتؤكد هذه النصوص كلها تأكيدًا واضحًا أن "اليوم" عند الله - أي أبديته - هي الآن، وأنها بدأت بمجرد مجيء يسوع بيننا. وما يقوله القديس يوحنا هنا، ليس سوى استنتاج لما تعنيه كلمات يسوع: "فأخذ يقول لهم: اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم" (لو4/21).
وهنا نعود إلى كلمة يسوع إلى الصدوقيين: "فاملأوا أنتم مكيال آبائكم" (متى 23/32). إن إله آبائنا إله أحياء وإبراهيم وإسحق ويعقوب أحياء، فيسوع هنا يتحدث عن القيامة! "ابتهج أبوكم إبراهيم راجيًا أن يرى يومي ورآه ففرح" (يو 8/56). فهل يقصد يسوع أن إبراهيم الذي مات قد قام بالفعل؟ إن هذا هو ما يبدو أن النص يشير إليه. كيف يمكننا أن نفهم هذه العبارة إلا بأن نفهم أن الموت يخرجنا من الزمن وأنه بالموت نصبح في "آنية" الله، أي في زمنه، والذي لا يشبه الزمن في شيء.
ومع التجديد في تفسير الكتابات المقدسة وفي إطار علمي وثقافي حديث، أقلع العديد من اللاهوتيين اليوم - من جهة - عن المفهوم الأنثروبولوچي الإغريقي للإنسان الذي يقسمه إلى جسد ونفس عائدين إلى مفهوم الشعوب السامية. ومن جهة أخرى، قادهم تفكيرهم في الزمن والأبدية إلى تبني مفهوم "القيامة في الموت"، وأخيراً مالوا إلى فهم القيامة كتتويج لتأليه الإنسان الذي افتتح بالعمل الخلاصي للمسيح وهو عمل إلهي صِرْف ومجاني تمام المجانية. ويتبنى هذا اللاهوت رؤية إنجيل يوحنا ويبتعد عن رؤية الأناجيل الإزائية ليتفادى الوقوع في الإطار الزمني المكاني الذي تعبر عنه هذه الأناجيل.
ولكن الكنيسة الكاثوليكية في تعليمها التقليدي تتردد في تبني هذه المواقف. ويشدد الكاردينال جوزيف راستينجر (البابا الحالي بنديكت السادس عشر) في نص له عن الحياة الأبدية وما بعد الموت صدر في عام 1979 عن مجمع العقيدة الإيمانية، على ضرورة الإيمان ببقاء النفس بعد الموت معارضاً بذلك نظرية اعتبرها "لا تمثل بأي شكل من الأشكال الإيمان المشترك، كما تفهمه جماعة المؤمنين".
إن مفهوم الإنسان كمكون من جسد ونفس متجذر تجذرًا كليًا في التقليد الكنسي الشائع، بحيث يصعب تغييره. وينطبق الأمر نفسه على التعليم التقليدي والشائع للكنيسة الكاثوليكية، والذي يفترض أنه عند موتنا، فروحنا ستصعد إلى السماء أو تذهب إلى جهنم، كلٌّ على حسب أعماله. وعند نهاية العالم، سيقوم الأبرار إلى الحياة الأبدية ويقوم الأشرار إلى اللعنة الأبدية. ويبقى التعليم التقليدي للكنيسة الكاثوليكية عن الحياة بعد الموت أقرب إلى اتجاه الأناجيل الإزائية منه إلى إنجيل القديس يوحنا.
يختلف التقليد القبطي الأرثوذكسي بعض الشيء عن التقليد الكاثوليكي، فبالنسبة للتقليد الأرثوذوكسي، يذهب الأبرار بعد الموت إلى الفردوس بينما يذهب الأشرار إلى الجحيم (أو مثوى الأموات). وهم جميعاً ينتظرون نهاية العالم والدينونة الأخيرة للأحياء والأموات، ففي نهاية العالم ستقوم القيامة وتتم الدينونة وسيدخل الأبرار إلى ملكوت الله بينما يلقى بالأشرار إلى جنهم.
ويمتاز هذا اللاهوت بأنه يضفي قيمة للدينونة الأخيرة أكبر من تلك التي يضفيها التقليد الكاثوليكي، ولكن ينقصها أنها تحرم الأبرار - قبل القيامة - من رؤية الله وجهاً لوجه هذه الرؤية الطوباوية. ويتحول الفردوس والجحيم إلى صالتي انتظار مع أن مصير كل فئة محدد سلفاً، دون أن تضيف حالة الانتظار أي نتائج. ولابد أن يجلس لاهتيو التقليديين معًا للبحث عن حل أكثر ملائمة انطلاقًا من الكتاب المقدس، وهذا موجود بالفعل في برنامج العلاقات المسكونية بين الكنائس.
ماذا يمكن أن نقول في الخلاصة؟
تطورت العقائد على مر الزمن تطورًا كبيرًا ولكن يبقى أمر ثابت: إن موتانا أحياء! أين؟ متى؟ كيف يحيون؟ الأسماء والأشكال تغيرت، لكن الأمر يبقى واحداً. وتظل الاختلافات على أين وكيف ومتى، ولكن الإيمان بالقيامة بالنسبة لنا نحن المسيحيين يعد إيماناً مشتركاً ومؤسساً. فإن لم نؤمن بذلك تعرضنا للوم يسوع: "فأنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف لكم أن تهربوا من عقاب جهنم؟" (متى 23/31 - 33).
ولا يتأسس هذا الإيمان في القيامة على ضرورة عدالة الله بل على قيامة يسوع، فقبر يسوع فارغ وأما موتانا فهم ليسوا أحياء في قبورهم. ولا يهم في حياتهم - تلك الحياة الحقيقية - أن يكونوا هنا أو هناك، أو أن تكون صورتهم على هذه الهيئة أو غيرها ولكن أنهم يعرفون الله ويرونه وجهًا لوجه. وهذا هو عمل الله الخلاصي، المجاني كل المجانية، وعمل حبه غير المفهوم والمجنون!
هذا هو عمل الله! فالله يحبنا ونحن نعرف الحب لأنه أحبنا ونحن بعد خطاة. ونلنا الخلاص بموته وفي قيامته قمنا. هذا هو إيماننا وهو إيمان يهبنا الحياة. إن هذا منبع سعادتي وأعيش في دهشة أمام سر الحياة هذا، حياة تقودنا إلى الحياة، نتحد فيها مع كل من سبقونا في هذه التجربة الكبرى، فهم هنا معنا ونحن معهم وهم يصلون لي كما أصلي لهم.
ونحن واحد في جسد المسيح الممجد له كل مجد وشكر!
***
"رأيت بعد ذلك
جمعً كثيرًا لا يستطيع أحدٌ أن يحصيه، من كل أمةٍ وقبيلةٍ وشعبٍ ولسان،
وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حللاً بيضاء، بأيديهم سعف النخل،
وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون:
"الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل!"
وكان جميع الملائكة قائمين حول العرش والشيوخ والأحياء الأربعة، فسقطوا على وجوههم أمام العرش وسجدوا لله قائلين:
"آمين! لإلهنا التسبيح والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقدرة والقوة أبد الدهور آمين!".
فخاطبني أحد الشيوخ قال:
"هؤلاء اللابسون الحُلل البيضاء، من هم ومن أين أتوا؟"
فقلت له: "يا سيدي، أنت أعلم".
فقال لي: "هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى، وقد غسلوا حُللهم وبيضوها بدم الحمل.
لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهارًا وليلاً في هيكله،
والجالس على العرش يظللهم،
فلن يجوعوا ولن يعطشوا
ولن تلفحهم الشمس ولا الحر،
لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة،
وسيمسح الله كل دمعةٍ من عيونهم".
(رؤ 7/9 - 17)