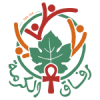بقلم الأب فاضل سيداروس اليسوعي
تتميّز الروحانيّة الإغناطيّة بسمتين: فهي روحانيّة علمانية وإنسانية.
روحانيّة علمانيّة:
تتصف الروحانيّة الإغناطيّة بأنها روحانيّة علمانيّة، بمعنى أنّ إغناطيوس قد وضع أسسها ومعالمها إذ كان علمانيًا، لا كاهنًا أو راهبًا، وذلك على خلاف معظم الروحانيّات الكنسية الشعبيّة التي وضعها رهبان أو كهنة. فإنّ مجمل ملامح الروحانيّة الإغناطيّة حاضرة في كتاب الرياضات الروحيّة. وهذا المؤلف هو ثمرة خبرة إغناطيوس الشخصيّة وخلاصتها إذ كان بعد علمانيًا. وجميع خطوات هذه المسيرة الروحيّة بل والتصوُّفيّة قد خطاها إغناطيوس وهو علمانيّ، لم يُفكِّر لا في الكهنوت ولا في الرهبنة. فروحانيّته نابعة إذًا من مؤمن علمانيّ، كما أنّها موجّهة إلى العلمانيِّين.
فإن تأثّرت بعض الحقبات من تاريخ الكنيسة بالرهبان خصوصًا؛ وإن كانت كنيسة المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 – 1967) كنيسة الأساقفة خصوصًا؛ فكنيسة القرن الحادي والعشرين ستكون – على ما يبدو – كنيسة العلمانيِّين الذين سيقومون بدورهم الفعّال فيها وسيُبرزون مواهبهم الكنسيّة فيها (بدون أن يُهمل دور الأساقفة الرائد، ولا دور الرهبان النبويّ). فمواهب الروح القدس متنوّعة، وحان الوقت لتظهر مواهب العلمانيِّين في الكنيسة.
وبناءً على ذلك، فإنّ تنشئة العلمانيِّين، والثقة بهم وبقدراتهم الروحيّة والخدمية والكنسيّة... لمن الأمور المُلِّحة في مطلع هذا القرن وهذه الألفيّة. فكلُّ ما من شأنه أن يُساهم في تكوين العلمانيِّين وفي فتح مجالات جديدة لتحملُّهم مسؤوليّات في الكنيسة، إنمّا يواكب هذا الاتِّجاه الذي أعرب عنه قداسة البابا.
فإن كان الأمر كذلك، فإنّ الروحانيّة الإغناطيّة العلمانيّة تُمثِّل فرصة ذهبيّة للكنيسة جمعاء، ولا سيّما لأولئك الذين ينتمون إليها، مثل "رفاق الكرمة". وكلّما تعمّق العلمانيُّون الإغناطيُّون في روحانيّة مؤسِّسهم العلمانيّ، إنمّا هم يواكبون الاتِّجاه الذي تسير فيه كنيسة القرن الحادي والعشرين.
روحانيّة إنسانيّة
نشأ إغناطيوس وترعرع في غضون النهضة الأوربيّة في القرن السادس عشر. وقد ركّزت اهتمامها على "الإنسان" ودوره في الكون والتاريخ، وفي التطوُّر والتقدُّم؛ وذلك بفضل الاكتشافات العلميّة والجغرافيّة، والثقافيّة والمطبعيّة... وعصرنا يتّسم باهتمامات وتطلّعات وإنجازات مماثلة.
وقد تأثرت الروحانيّة الإغناطيّة بهذه الروح، حتّى إنّ أول كلمة من "المبدأ والأساس" هو: "الإنسان". فروحانيّة إغناطيوس العلمانيّة روحانيّة إنسانيّة محض، محورها وفاعلها وهدفها إنّما هو الإنسان. وفي ذلك تشابه عظيم وعصرنا هذا.
إلا أنّ الإنسان – بحسب إغناطيوس – مغمور في الله، وليس إنسانًا مستقلاً عن الله. فيُضيف النصُّ المذكور هذه الكلمات: "الإنسان يُخلق ليُسبِّح الله ويُكرِّمه ويخدمه...". وينتهي النصُّ بهذه الكلمات: ".... ما يزيدنا اهتداء إلى الغاية التي لأجلها نُخلق"، وهي الله. فكلمة الإنسان الأولى والأخيرة إنّما هي الله – في المنظور الإغناطيّ – وذلك على خلاف نهضة عصره، أو تفوُّق عصرنا. فقد صحّح إغناطيوس ما قد يعتري الإنسان من كبرياء أو تسلُّط، ومن استقلال بدون مرجعيّة الله. فملحمة إغناطيوس هي ملحمتنا نحن في تعظيمنا للإنسان. الإنسان المغمور في الله.
وهناك أمرٌ آخر يجعل إغناطيوس قريبًا منّا، وهو تركيزه على جميع أبعاد الإنسان، ولا على حياته الروحيّة فقط. فقد تحدّث عن الإنسان كله، أي بجميع أبعاده النفسيّة والروحيّة، والعقليّة والوجدانيّة والاجتماعيّة والعمليّة... فلنتذكّر تقدمة ختام "الرياضات الروحيّة": "خذ واقبل، يا ربّ، حرِّيتي كلها، وذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها. كلّ ما هو لي وما عندي...". فالإنسان كله – بجميع أبعاده – هو من الله وإلى الله ولله. وعليه، فالإنسان الإغناطيّ لا يهتمّ بالروح فقط، بل بالإنسان كله وبكلّ ما يُكوِّن لحمة حياته.
ومّا يلفت النظر أيضاً أنّ روحانيّة إغناطيوس مُفعمة بالتعابير الوجدانيّة: الحبّ الرغبة، الشعور، التأثُّر، التذوُّق، الانبساط، الانقباض... وذلك على خلاف تيّار ساد الكنيسة يُركِّز على العقل أو الإرادة أو التجرُّد من المشاعر... فإغناطيوس قد وُفِّق إذ دمج الوجدان في حياة الإنسان الروحيّة، كعنصر مهمّ منها، ولكن دونما الوقوع في فخِّ العواطف والأحاسيس المتأجِّجة التي تُفقد الإنسان صوابه وحكمته وتمييزه.
وتأكيدّا لذلك، لنتذكّر أن آخر مُشاهدة يعرضها إغناطيوس في "الرياضات الروحيّة" – كثمرة لها ولمسيرتها – إنّما هي "المشاهدة لبلوغ الحبّ". فالمتريِّض ينطلق من رياضته الروحيّة إلى حياته اليوميّة وهو يسعى أن يبلغ الحبّ: حبّ الله وحبّ الخليقة وحب الإنسان. وإنّه يُترجم هذا الحبّ في الخدمة: فآخر نعمة يطلبها المتريِّض هي أن "يحبّ عزّته الإلهيّة ويخدمها في كل شيء".