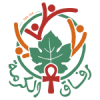بقلم الأب داني يونس اليسوعي
الإنسان على صورة من يعبد، ينمو بحسب نظرته إلى الله. تجد البعض ثائرين متمرّدين يخبرون عن يسوع أنّه الثائر الدائم، وتجد الآخرين مسلّمين قانعين يتمثّلون بيسوع الحمل الوديع الّذي يقبل مصيره ويحمل صليبه راضيًا بمشيئة الله. الأوّلون يروون قصّة الكتاب المقدّس على أنّها قصّة إله ينظر إلى واقع البشر ويرغب في تغييره لأنّ الإنسان مستعبد مقهور ويدعو إلى خدمته بشرًا أنبياء يدعون إلى التوبة يندّدون بالظلم يتحدّون السلطة يقلبون الموائد. وترى الآخرين يكلّمونك عن إله خلق العالم حسنًا وخلق الإنسان حسنًا جدًّا، وحين خطئ أتى ليخلّصه والحكيم الّذي يعرف الله ويثق به يعرف أنّ كلّ شيء نعمة، وأنّ الواقع أجمل من كلّ الأحلام لأنّ الواقع قد أخصبه الله وصيّره وعدًا بحياة جديدة، ولذلك على الإنسان أن يقبل مصيره كما هو لأنّ الخطيئة تقوم على التمرّد ورفض الواقع.
نظرتان إلى الله تخلقان نوعين من التلاميذ: الأنبياء الثائرين والحكماء القانعين. ومع أنّ لكلّ نظرة ما يبرّرها نجدهم ينتقدون بعضهم الآخر ساخرين هازئين. فالداعون إلى التغيير يشيرون إلى أنّ الواقع كما هو قبيح: الإنسان يستعبد الإنسان والخطيئة لا تقتصر على أفعال سيّئة بل تصير بنى إجتماعيّة تطحن الإنسان. حين نقول للمظلوم أن يقبل مصيره وللفقير أن يرضى بنصيبه باسم الدين والإيمان، ألا نكون قد اخترنا أن نخدم الأغنياء والمتسلّطين على حساب الفقراء المستضعفين؟ ألا يصير الإيمان أفيونًا للشعوب؟ ألا يتحوّل إلى أداة استغلال؟ هؤلاء التلاميذ يرون مجد الله في رفض الواقع كما هو وفي العمل على تغييره ولو كلّف الأمر التضحية بالذات، فيسوع مات لأنّه واجه الكتبة والفرّيسيّين الّذين جعلوا الدين سلاحًا ضدّ الله وضدّ الإنسان. أمّا الداعون إلى القنوع فيشيرون إلى أنّ المسيح مات قبل كلّ شيء ليكفّر عن خطايانا وأنّه خلّصنا بأنّه أطاع إرادة الآب وقبلها كما هي وهو يدعونا إلى قبول صليبنا على مثاله. فالله هو الّذي يخلّص ونحن لا نستطيع أن نخلّص أنفسنا فإن اجتزنا هذه الحياة واثقين به وصلنا إلى الحياة الأبديّة معه. لأنّ هذا العالم سيمضي ومعه أحزانه. وبعضهم يرفض أن يتّهمه الآخرون بالخنوع والضعف مشيرًا إلى أنّ المسيح يدعونا إلى تغيير نظرتنا إلى الأمور: فالطوبى ليست للأغنياء بل للفقراء، وليست للضاحكين بل للحزانى، وليست للظالمين بل للمضطهدين. وفي كلّ الأحوال، من لا يقبل واقعه ولا يقبل ذاته ولا يقبل حدوده كيف ينمو؟ أليس النموّ قبولاً للواقع؟ أليس الطفل هو من يبني عالمًا وهميًّا فيه يملك قوى خارقة غير واقعيّة؟ أليس الناضج هو من يتعرّف تدريجيًّا إلى حدوده ويتعلّم كيف ينطلق منها لكي يعيش حياة جيّدة إن هو قبل ذاته وأحبّها كما هي؟
في هاتين النظرتين إلى الله نظرتان مختلفتان إلى مشيئته: هل مشيئة الله في التمرّد على الواقع أم في قبوله؟ الواقع ليس الله، ومن يتمرّد على الواقع لا يتمرّد بالضرورة على الله، ولكنّ مشيئة الله تنعكس في الواقع، ونحن نؤمن أنّ كلّ الأشياء تعمل معًا لخير من يحبّون الله. فكيف أميّز مشيئة الله؟ وفي موقف محدد ما هو الأكثر أمانة للإنجيل؟
يسوع يشفي بصرنا لنرى
في الإنجيل تبدو مشيئة الله أوّلاً في صورة دعوة إلى تغيير الذات، إلى التوبة، إلى تحويل العالم. يسوع ينادي بالتوبة ويذكّرنا أنّ الواقع كما هو ليس متناسبًا مع مشيئة الله. ليست مشيئة الله أن يكون الإنسان أسير الواقع وأسير الظروف. بل نرى في الكتاب المقدّس كيف يرسل الله موسى ليحرّر الشعب العبرانيّ من العبوديّة، ويرسل يسوع ليحرّر البشريّة من الموت. الله لا يريد الموت بل الحياة ونحن نجني على الله حين نقول إنّ مرض فلان أو موت فلانة هو إرادة الله. قصّة برطيماوس الأعمى (مرقس 10: 46-52) مثال صارخ على نظرة يسوع للأمور: برطيماوس يجلس على حافّة الطريق يطلب صدقة، وحين يعلم أنّ يسوع يمرّ في المكان يصرخ إليه طالبًا الرحمة. أمّا الناس فيحاولون إسكاته: لا تزعج المعلّم، اقبل واقعك، إلزم مكانك، هذه مشيئة الله في حياتك، أشكر الله بالرغم من صعوباتك، ألا تعلم كم من الناس يمرّون بظروف أسوأ منك؟ أمّا هو فكان صياحه يزداد حتّى استوقف يسوع. ناداه فنفض عنه رداءه وأتى إليه. سأله يسوع: ماذا تريد، قال: أن أبصر، فقال له يسوع: أبصر، إيمانك خلّصك، فأبصر من ساعته. بالنسبة ليسوع الإيمان هو مقاومة داخليّة تواجه العراقيل وتدفع بالإنسان إلى أن يقول رغبته أمام الله واثقًا أنّ الله يسمع له. بساطة برطيماوس أساسيّة: لن يسمح لنفسه بالدخول في دوّامات من الأفكار حول نفسه وحول الله، بل يقول رغبته كما هي، متّكلاً على الله.
ولكن في الإنجيل نجد موقفًا مختلفًا أيضًا. حين يتكلّم يسوع عن الكأس الّتي يجب عليه أن يشربها، كأس الآلام والموت، يقول أنّه يجب عليه أن يقبلها لأنّها مشيئة الله. بل في الليلة السابقة لآلامه طلب إلى الآب أن يبعد عنه هذا المصير ولكنّه ما لبث أن أضاف: مشيئتك لا مشيئتي. وكذلك دعا تلاميذه لأن يحملوا كلّ واحد صليبه ويتبعه، وبعد القيامة قال لبطرس: حين كنت شابًّا كنت تشدّ الزنّار وتذهب إلى حيث تريد، أمّا إذ صرت شيخًا شدّ لك غيرك الزنّار ومضى بك إلى حيث لا تريد، ويضيف الإنجيل: قال يسوع ذلك مشيرًا إلى الميتة الّتي بها سيمجّد الله. في هذه النصوص يظهر لنا المسيح وكلّ تلميذ له وكأنّه أمام طريق لا بدّ له من السير فيه، وتظهر مشيئة الله وكأنّها واقع لا مهرب منه يفرض نفسه علينا. بل تصير أحداث حياتنا تعبير عن مشيئة الله نقرأ فيها قصّة الخلاص الّتي يتمّمه الله فينا. في إنجيل يوحنّا نقرأ قصّة أعمى آخر، غير برطيماوس (في الفصل التاسع)، رآه تلاميذ يسوع وعرفوا أنّه أعمى منذ الولادة. فاحتاروا بشأنه لأنّهم كانوا يفهمون الألم أنّه عقاب من الله فإن كان قد وُلد أعمى فلا شكّ أنّ العقاب أنزله الله على الوالدين لأنّهما كانا خاطئين، ولكن إن كان هذا هو الواقع، ما ذنب الرجل المسكين يتألّم لخطيئة والديه؟ وإن كان هو الخاطئ ألا يجب أن تسبق الخطيئة العقاب؟ ولكنّه ولد أعمى فمتى خطئ إذًا؟ يسوع يجيب تلاميذه: ليس هو الخاطئ ولا والداه بل وُلد أعمى لتظهر فيه قدرة الله. قال ذلك ثمّ شفاه. يسوع كما تلاميذه يبحثون عن مشيئة الله في داخل الأحداث، في قلب الواقع. ولكن بالنسبة للتلاميذ معنى الأحداث نجده في الماضي: هو أخطأ أم والداه لهذا هو يتألّم. أمّا يسوع فيرى المعنى في المستقبل: لا يعبّر الواقع عن مشيئة الله في الماضي بل مشيئة الله هي عمل في الحاضر يعطي معنى لم يكن موجودًا. يسوع أيضًا يرى أنّ الواقع يعبّر عن إرادة الله، لكن لا الواقع الجامد كما هو، بل الواقع الّذي يفتح مجالاً للتغيير، للتجديد. لا شكّ أنّ الرجل الأعمى كان قد لعن مرارًا وضعه وساعة مولده بسبب ظروفه، ولكن بعد الشفاء ربّما يقول: بركة لي أنّي ولدت أعمى لكي أتعرّف إلى حبّ الله كما ظهر في يسوع. الواقع نفسه (العمى منذ الولادة) كان مصدر لعنة وصار مصدر بركة، كان له معنى سلبيًّا وصار له معنى إيجابيًّا، لماذا؟ لأنّ يسوع رأى في حالة هذا الرجل دعوة إلى إظهار مجد الله. لأنّ يسوع قرّر أن يضفي معنى جديدًا على هذا الواقع وكأنّه مفروض عليه: "يجب عليّ أن أقوم بأعمال الّذي أرسلني" يقول في الفصل ذاته.
القبول أو الرفض في حياتي أنا
الحلّ السهل هو أن أسأل نفسي: أيّ موقف يناسب شخصيّتي؟ ما الّذي ينجذب إليه قلبي: موقف برطيماوس أعمى أريحا، أم موقف المولود أعمى؟ هل أرتاح لتغيير الواقع، أم أرتاح بالأكثر لتغيير نظرتي إلى واقعي؟ كيف يشفيني الله؟ هذا الحلّ السهل قد يكون أحيانًا كافيًا، لأنّ شخصيّتي هي أيضًا نعمة من الله تدلّني على مشيئته في حياتي. ولكنّ الحلّ السهل كثيرًا ما يغشّ. لأنّي معرّض دائمًا لأن أفصّل إلهًا على قياسي وأعبده كما يريحني، أو أنا معرّض لأن أسجن نفسي داخل رأيي في نفسي أو رأي الآخرين فيّ فأقول: أنا بطبيعتي كذا وكذا ولهذا يجب أن أتصرّف كذا أو كذا. من أراد أن يطيع مشيئة الله حقًّا لا يختار الحلّ السهل.
ليس أعمى أريحا على حقّ أكثر من أعمى سلوام ولا العكس، فالكتاب المقدّس يعلّمنا أنّ لكلّ شيء وقت: للزراعة وقت وللحصاد وقت، للعمل وقت وللراحة وقت، وكذلك للتغيير وقت وللقبول وقت (راجع سفر الجامعة، الفصل3)، وحدها تسبحة الله يناسبها كلّ وقت كما يقول المزمور 34: تسبحته في فمي على الدوام، لأنّ تلميذ المسيح يسبّح الله في كلّ شيء يعمله، إن عمل أم استراح، إن أكل أم شرب، إن زرع أم حصد. وتمييز إرادة الله يمرّ دائمًا بتمييز الأوقات: هل الوقت الحاليّ هو وقت التغيير أم وقت القبول؟ وكيف أعرف ما الوقت؟ غالبًا ما أعرف انطلاقًا من خبرتي: إن أنا تمرّست على تمييز الأوقات ملاحظًا ما الّذي يأتي بنتيجة إيجابيّة وما الّذي لا يحمل ثمارًا على الإطلاق، أصل إلى مرحلة يمكنني فيها أن أعرف ما يجب عمله. أفضل وسيلة للنموّ في هذا الطريق هو ممارسة ما نسمّيه فحص الضمير، أو مراجعة الحياة.
الموقف الأساسيّ لمن يريد العمل بمشيئة الله هو موقف من يقول: "هاءنذا" لله، كما قال يسوع. فسواء ثار يسوع على الواقع أم قبله، فعل ذلك استجابة للآب. والاستجابة للآب أيضًا موقف ننمو فيه. يقول يسوع: من كان أمينًا على القليل كان أمينًا على الكثير. وكذلك من تعلّم أن يستجيب لله في الأمور اليوميّة البسيطة صار قادرًا أن يستجيب له في الأمور المصيريّة. ولذلك يسعى تلميذ يسوع أن يتعرّف إلى الآب يوميًّا ليعرف كيف ينظر الآب إلى الواقع، وأيّ موقف ينتظره الآب مني أنا، وهذا ما نتعلّمه بالصلاة والتأمّل كما نتعلّمه بمختلف أنواع الخدمة وأعمال المحبّة.
تمييز الأوقات والاستجابة للآب لا معنى لهما خارج مسيرة نموّ. هذه المسيرة هي إذًا أساس التمييز بين قبول الواقع وتغييره، ولذلك علينا أن نتنبّه إلى معيار أساسيّ في هذه المسيرة بدونه يصير كلّ تفكيرنا وقتًا ضائعًا، وهذا المعيار أسمّيه: المرور من اللعنة إلى البركة.
من اللعنة إلى البركة
قبول الذات (ما نسمّيه اختبار البركة وعكسها اللعنة) هو مبدأ أساسيّ في الحياة الروحيّة: الخلاص هو أن أريد أن أكون أنا وألاّ أفضّل على ذلك أن أكون غير أنا. ولكن هذا القبول ليس وصيّة مفروضة عليّ بل وعدًا يعطيني إيّاه الله ورجاء أتعلّق به. لذلك هذا القبول هو نتيجة، نتيجة بحث وجهد وصراعات داخليّة، ولكنّه أيضًا نعمة تنمو فيّ بدون أن أعرف وتحمل ثمارها في أوانها. فكما أنّ الزارع يتعب ويجتهد ولكنّه لا يعرف كيف تنمو النبتة وتحمل الثمار، كذلك أنا أجتهد لكي أتوصّل إلى قبول ذاتي على أنّي محبوب من الله ومبارك منه ولكنّي لا أعرف كيف ومتى وبأيّ شكل تأتي ثماري.
قبول الذات يرتكز على إيماني بالله. أرفض أن يكون الله إله أمر واقع، مفروضًا عليّ من الخارج، لأنّ لا أحد ولا حتّى الله يستطيع أن يفرض عليّ أن أبارك حياتي إن لم أصل إلى هذه البركة من الداخل. أرفض أن أبارك إلهًا غير قادر على أن يخاطب قلبي، وأرفض أن أدع العراقيل تعوقني عن الصراخ إليه، بل أراهن على أنّه يريدني أن أحيا بملء الحياة. ليس الله عدوًّا لي. بالمقابل أنظر وأدقّق النظر لكي أرى كيف أنّني كثيرًا ما أكون عدوّ نفسي: أنا أضع لنفسي شروطًا للسعادة ليست ضروريّة: سأكون سعيدًا لو كان لديّ المال، سأكون سعيدًا لو كان لي الجمال، ... كلّ هذا هو رفض للذات أنمّيه في نفسي يومًا بعد يوم إلى أن يصل بي الأمر أن أقتنع أنّ الله عدوّي لأنّه يحرمني هذا كلّه.
نحن نختبر واقعنا على أنّه مزيج من البركة واللعنة. في حياتنا ما يقودنا إلى الفرح وفيها ما يشلّنا عن الفرح. ثقتنا بالله تدعونا إلى أن نرى في كلّ لعنة بركة مخفيّة، والطريق الروحي هو الّذي يكشف البركة المخفيّة في كلّ لعنة. ليس المقصود أن أسمّي اللعنة بركة وأتظاهر بأنّي أقبلها، ليس المقصود أن أقول "كلّ شيء نعمة" فيصير كلّ شيء جميلاً، وألوم نفسي أنّي لا أشكر الله كفاية. بل المقصود أن أسمّي الأشياء بأسمائها إلى أن أكتشف كيف يحوّل الله حياتي إلى بركة مستمرّة. في حياتنا أحزان لا تشفى بأن ندّعي قبولها، أو بأن "نتحمّلها" في سبيل الله، بل تشفى إذا تمرّدنا عليها مراهنين على أنّ الله قادر أن يستخرج منها ما هو خير وأن يعطيها معنى ليس فيها.
عملياًّ ...
ما قلناه إلى الآن يركّز على مسيرة النموّ، النموّ في الحكمة (تمييز الأزمنة)، النموّ في معرفة الله والاستجابة له، المسيرة من اللعنة إلى البركة... ولكن للنموّ وقت وللقرار وقت آخر. النموّ تدريجيّ يمرّ عبر مراحل ويتحسّن بالتدريب، ولكنّني أحتاج إلى معايير لأميّز مشيئة الله في ظروف محدّدة تتطلّب موقفًا وقرارًا. فكلّ ما قلناه إلى الآن يجب أن يوجّهنا لتحديد معايير عمليّة للتمييز. لا أقول أنّه يعطينا حلاًّ مسبقًا وأجوبة جاهزة، ولكنّه يساعدنا على تجنّب بعض الأخطاء الشائعة. هذه بعض المعايير:
- تسمية الأشياء بأسمائها: إن كنتُ أختبر البركة أم كنتُ أختبر اللعنة، أكون صريحًا مع ما أختبره. لا أنظر إلى واقعي كما "يجب" على شخص "جيّد" أن ينظر، بل أجتهد أن أراه كما هو.
- آخذ الطريق الّذي يبدو لي مفتوحًا ويعطي ثمارًا وفرحًا، ولا آخذ الطريق الّذي يسجنني في الغضب أو الاختناق أو الحزن.
- حين ليس لديّ الاختيار، مثلاً حين أكون مريضًا، أو حين أفقد شخصًا عزيزًا، أو لا أجد عملاً، لا يمكنني أن أغيّر واقعي، ولا يمكنني بسهولة أن أقبله، أقبل على الأقلّ غضبي ورفضي ولا أعقّد الأمور بأن أرفض رفضي أو بأن أغضب لأنّي غاضب... نحن نسجن أنفسنا في كلمة "المفروض" فنقول: المفروض عليّ أنا المؤمنة أن أتحمّل، المفروض عليّ أنا المؤمن ألاّ أتمرّد. نحن ننسى أنّ الوصايا في الكتاب المقدّس ليست أوامر بل وعود. حين يقول الكتاب: "افرحوا بالربّ دائمًا" أتساءل: كيف يمكنني أن أفرض الفرح على نفسي؟ ما يقوله الكتاب ليس فرضًا بل وعدًا: ابحثوا عن الفرح دائمًا لأنّ الله وعدنا به ونحن نعلم أنّ وعوده صادقة.
- لكلّ يوم من العناء ما يكفيه: لا أسعى لأن أحلّ المشاكل كلّها في موقف واحد. بل أقبل نعمة اليوم على قدر استطاعتي وأنتظر واثقًا نعمة الغد حين يأتي وقتها. مثلاً: كثيرون يختبرون صعوبة المغفرة للآخرين. المغفرة صفة إلهيّة والله يعطينا إيّاها على قدر استطاعتنا. يكفيني اليوم أن أغفر قليلاً عالمًا أنّ الله سيكمّل في ما بدأه. وكذلك: كثيرون يمتنعون عن العمل على تحسين الواقع لأنّ "ما فيش فايدة"، لأنّ هناك أمور لا يمكن تحسينها. موقف اليأس هذا يأتي بسبب رغبة في حلّ المشاكل كلّها دفعة واحدة. يكفيني اليوم أن أعالج ما أقدر عليه.
- مواجهة الدوافع السيّئة: كثيرًا ما يخطئ الإنسان التمييز بين ضرورة التغيير أم ضرورة قبول الواقع بسبب دوافع خفيّة في قلبه أهمّها ثلاثة: الخوف، المصلحة الشخصيّة، واليأس. المخاطر كثيرة، فلو سمحنا للخوف أن يقرّر عنّا لما فعلنا شيئًا. من الطبيعيّ أن أمتنع عن المخاطرة بحياتي في سبيل أمور تافهة ولكن هنا ليس الخوف الّذي يمنعني، بل العقل الّذي يزن الأشياء ويرى قيمة كلّ شيء. أمّا إذا امتنعت عن اتّخاذ مواقف أساسيّة في حياتي بسبب الخوف أفقد حياتي من كثرة خوفي عليها. بخصوص المصلحة الشخصيّة كثيرًا ما نوهم أنفسنا بأسباب لاتّخاذ قرار أو للامتناع عنه في حين أنّ السبب الرئيسيّ الخفيّ هو حفاظنا على مصلحة شخصيّة. من المفيد دائمًا أن أقيّم أسبابي بشكل موضوعيّ وذلك من خلال نظرة الآخرين لأسبابي. أمّا الدافع الأصعب فهو اليأس الخفيّ السرّيّ الّذي دفعنا إلى عمل واجبنا بأمانة ولكن بدون انتظار أيّ شيء جديد، بدون توقّع أيّة ثمار. بسبب هذا اليأس لا يعرف الإنسان متى عليه أن يعمل على تغيير واقعه ومتى عليه أن يقبله برجاء. قد يتكلّم عن الرجاء ويبدو فرحًا ويعمل واجبه بنشاط ولكنّه لا يستطيع أن يستجيب لنداء الله لأنّه لا يسمعه، ولا يسمعه لأنّه لا ينتظره.
هذه المعايير تساعد حين يتساءل الإنسان إن كان عليه العمل على تغيير الواقع أو على تغيير نظرته للواقع. في الحالتين هي تنفع إن كان الإنسان يريد أن يخدم إرادة الله. وأمّا معرفة إرادة الله معرفة باطنيّة حميمة فلا تأتي إلاّ في داخل مسيرة من النموّ لا تكتمل.
كيف أكمل التفكير ؟
1- فيلم The Mission يضع شخصيّتين مختلفتين في مواجهة، مع أنّ الشخصين يريدان اتّباع المسيح. أيّ طريق تجده أقرب إلى المسيح؟ (تجد الفيلم عند الآباء اليسوعيّين)
2- اقرأ المزمور 22 (21): إلهي إلهي لماذا تركتني... لاحظ الانتقال من اللعنة إلى البركة. يسوع قال هذا المزمور على الصليب: كيف يساعدك هذا المزمور على فهم سرّ الصليب؟
3- (في جماعة) إن كان لديك خبرة مع الوسائل المعروضة في هذا المقال، يمكنك أن تقيّمها: هل أفادتك؟ بأيّ طريقة؟ وإن لا: ما هي العراقيل يا ترى؟