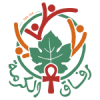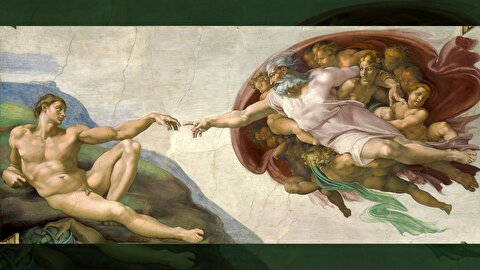
بقلم الأب داني يونس اليسوعي
كنّا في باريس أيّام دراسة اللاهوت. سألني أحدهم ما هي رياضات القدّيس إغناطيوس؟ فأخذت أشرح له فخورًا كيف أنّ "الرياضات مسيرة في الصلاة تساعد الإنسان على اكتشاف إرادة الله على حياته" (هكذا نقول بالفرنسية، مشيئة الله على فلان، ولكن بعد أن حصل ما حصل لم أعد أستخدم هذا التعبير). هنا اقتربت منّي زميلة في الدراسة وقالت: عذرًا، هل قلتَ "مشيئة الله"؟ هل لله مشروعٌ لحياتي. فقلتُ لها بحماسة من يعرف شيئًا خفيًّا يريد أن يكشفه: طبعًا! أجابت: كان لوالديّ مشاريع لي، وكذلك أخي، وأصدقائي، والآن يضع لي زوجي مشاريع لحياتي وكذلك حمواي، وبدأ أولادي يتعلّمون كيف يضعون مشاريع لي، فهل أضيف الله إلى القائمة؟ صدمني جوابها وسمعت نفسي أقول لها: لا، بالطبع لا، ليس لله مشروع آخر سوى تحطيم المشاريع الّتي يقيمها الآخرون أو حتّى نقيمها نحن أنفسنا على حساب حياتنا، ولكن أليس هذا أعظم المشاريع وأجرأها؟؟
من يومها وأنا أفكّر بكلامها وبالردّ الّذي انتزعته منّي انتزاعًا. لم أعد أستخدم عبارة مشيئة الله "على" حياتي لأنّ مشيئة الله "هي" حياتي. الله يفكّك المشاريع الّتي تستعبدني، سواء تلك الّتي وضعها الآخرون لي أو الّتي وضعتها لنفسي. ليست مشيئة الله قرارًا بشأني يجعلني راهبًا أو طبيبة أو محاميًا أو رسّامة. وليس التمييز الروحيّ وسيلة لكي أحزر هذا القرار الّذي يسبقني وأكتشفه كما تحزر عرّافةٌ البخت حين تنظر إلى كرتها البلّوريّة أو خطوط القهوة في فنجاني. مشيئة الله لا تتعارض مع رغبتي لأنّ رغبات الإنسان هي صور متنوّعة لرغبته الأساسيّة الّتي هي الله. لهذا لا أتكلّم بعد اليوم على معرفة إرادة الله على حياتي (إلاّ عن سبيل التشبيه، مثل الكتاب المقدّس)، ولكنّي أتكلّم بالأحرى على "اختبار مشيئة الله" أي اختبار سقوط الأصنام في حياتي ونموّي في الحرّيّة والفرح. نعم قد يكون اختبار إرادة الله مخيفًا ولعلّي لا أزال حَذِرًا مع الله ولكن هذا الحذر ليس مرجعه أن لله إرادةً قد لا تعجبني، بل أنّ الحرّيّةَ مخيفةٌ، والله يحرّرني من أوهامي الّتي بدأت أرتاح إليها وأُسكِت بها مخاوفي ويضع ثوابتي الّتي بنيتُها على مرّ السنين موضع تساؤل. نعم قد يكون اختبار الله مخيفًا لأنّ حياة الإنسان تتجلّى حين يواجه مخاوفه. ولكن فلنمشِ خطوة خطوة.
الخلق دعوة إلى الوجود
كثيرًا ما تعود صعوباتنا في العلاقة مع الله إلى تصوّر خاطئ بشأنه. وما نموّنا الروحيّ إلاّ اكتشافٌ متجدِّدٌ لله وتحرّر من صورةٍ له مشوَّهةٍ. مثلاً هناك من يرى في الله شرطيًّا لا همّ له سوى أن نحترم القانون ولا يغضّ طرفه عن تجاوزاتنا إلاّ إذا راضيناه ببعض الأعمال الصالحة أو الصلوات والعبادات. هذه الصورة تمنع علاقتنا بالله من أن تنضج وتصل إلى مستوى الثقة الحقيقيّة. يعاني من ينظر إلى الله هذه النظرة إمّا من يأس داخليّ شديد لعدم شعوره بقبول الله وحبّه، وإمّا من كونه يخفي يأسه تحت كمّيّات كبيرة من الممارسات التَقَويّة والأعمال الصالحة ظانًّا أنّها ضمان كافٍ ضدّ الشرطي ّ الأعظم.
هناك في مجتمعنا أيضًا من يرى في الله صديقًا خفيًّا، زميلاً وصاحبًا لا يُرى، يروي له أخباره ويتفهّمه ويرافقه في أحزانه ويعضّده، إلهًا غير مخيف لا يحبّ أن يرى فيه ديّانًا ولا يصدّق أنّه قد يغضب. من يسجن الله في هذه الصورة يحكم على نفسه بأنّ علاقته بالله لن تغيّر حياته ولن تنمّيه، لأنّه يُسكِت تطلّب الله بواسطة المشاعر الحميمة ويصير الله له مُسَكّنًا والإنجيل مجرّد مادّة للاستهلاك العاطفيّ. هذا الشخص ضحيّة مرض "السُكّر الروحيّ": يُحَوِّل ملح الإنجيل إلى سكّر، يخلق الله على صورته ومثاله بدلاً من أن يَدَع الله يخلقه على صورته هو ومثاله.
ولكن سوء تصوّرنا عن الله الخالق وعن فعل الخلق نفسه هو بلا شكّ المصدر العميق لكثير من حذرنا تجاه الله. نحن نتصوّر الله يصنع الأشياء والبشر ويضع لها القوانين والشرائع وعلى المخلوقات أن تطيع خالقها. وإن كانت المخلوقات عاقلة وحرّة مثل الإنسان، وَجَب عليها أن تفكّر أنّ الخالق أدرى منها بما يفيدها، ولذلك فإنّ الشريعة النازلة من السماء هي بلا أدنى شكّ الأفضل لها، ولذلك فعليها طاعة الشريعة ومقاومة رغباتها الخاصّة. وكأنّ الله صنع الخليقة وأعطانًا "دليل المستخدم". ومشيئة الله على حياة كلّ إنسان هي إذًا في صالحه (كما يقول لنا أهالينا: "ده علشانك") وعلى الإنسان أن يسعى لمعرفتها وطاعتها. في رأيكم، ألا يعيش الإنسان في قلقٍ مستمرّ من نوع: "ماذا لو كان الله يريد أن أصير راهبة؟" أو "أرجو أن يريد الله أن أعمل في هذا المكان لأنّي أحبّه..."؛ في رأيكم، أليس هذا القلق دليل حذر بين الله والإنسان؟ كيف أحبّ من أحذر منه إذن؟
ولكنني أومن أنّ الخلق غير الصورة السابقة بالمرة. الخلق هو دعوة إلى الوجود. حين يخلق الله يدعو الكائنات إلى أن تكون لأنّه يريدها أن تكون. الله يحبّ ما يخلق وحبّ الله بلا شروط. أصدقائي يريدوني أن أكون ... مَرِحًا، أهلي يريدونني أن أكون ... ناجحًا، صديقتي تريدني أن أكون ... قويًّا، أنا أريد أن أكون ... جذّابًا. وحده الله يريدني أن أكون... فقط، أن أكون وحسب. لأنّ الخلق هو كلمة "كُن"، لا "كن كذا أو كن كذا". أن يكون الخلق دعوة إلى الوجود يعني أنّ غاية مشيئة الله هي أن أكون وما يُغضِب الله هو كلّ ما يعوقني عن أن أكون، وبالأكثر الكذبة الّتي تردّد في أعماقي أنّ الله يجب أن أحذر منه وأن أسترضيه أو أنّه يريدني كذا أو كذا. وطاعتنا لمشيئة الله الّتي يدعونا إليها الكتاب المقدّس بإلحاح ما هي إلاّ الإصغاء العميق والمؤمن إلى دعوة الله لي أن أكون، ورفض الإصغاء إلى كلّ ما يسير بعكس هذا الصوت. التمييز الروحيّ هو التدرّب على ترتيب الحياة وتنظيمها بحسب هذا الصوت.
البركة واللعنة
يُقال إنّ الفينيقيّين برعوا في الملاحة أكثر من معاصريهم من إغريق ومصريّين وغيرهم لأنّهم اكتشفوا في عمق البحر المتوسّط تيّارًا ثابتًا يجري باتّجاه الغرب. ففي الوقت الّذي كان فيه الآخرون ينتظرون الرياح المؤاتية ولا يرفعون الشراع إلاّ إذا أتت الرياح كما تشتهي سُفُنُهم، كان الفينيقيّون يُنزِلون الشراع في الماء لكي يصلوا إلى هذا التيّار العميق ويدعونه يقودهم إلى وجهتهم مهما كانت حالة الرياح على السطح. لا أدري إن كانت هذه المعلومة الغريبة صحيحة تاريخيًّا، ولكنّها صورة مفيدة تُحَرِّك تفكيرنا. السطح متذبذب، يومًا يأتي في صالحنا وأيّامًا ضدّنا. في الحياة ما يقول "نعم" لوجودنا أحيانًا ثمّ يقول "لا" في أحيان أخرى. ظروف حياتنا تدفعنا إلى الأمام أحيانًا، ثمّ في أحيان أخرى تعوق نمونا. حتّى في أصفى اختبارات الحبّ البشريّ نصادف التذبذب ومعه الألم. في الصداقة نختبر الخيانة المقصودة وغير المقصودة. في عمق حبّنا وعد لا نستطيع أن نفي به: أعد الآخر ب "نعم" لا يشوبها "لا"، ولكنّي أختبر حدودي يوميًّا. أرى محبوبي يعاني الوحدة ولا أستطيع أن أصل إليه، أو أشعر أنّ للحبّ تطلّبات لا أقدر عليها. السطح متذبذب لا يستقرّ على قرار. أمّا في العمق فتيّار ثابت طوبى لمن يجده. في عمق كياننا دعوة إلى الوجود بها يخلقنا الله، وهي ثابتة لا تتغيّر، لأنّ الله وحده يعرف ما الحبّ. الخلق دعوة إلى الوجود لا يشوبُها ندم، "نعم" لا تشوبها "لا"، بركة لا لعنة فيها. البركة هي "نعم" نقولها لوجود الآخر، واللعنة "لا". في الله بركة لا يشوبها لعنة، لذلك يعلّمنا القدّيس بولس: "باركوا لا تلعنوا". وأمّا اللعنة فتأتي من حذرنا من الله وعدم الثقة به، فلا يسمع الإنسان دعوة الله إلى الوجود بكلّ صفائها، ويفقد التيّار العميق ويصير تحت رحمة ذبذبات السطح، "يوم لك ويوم عليك" كما تقول الحكمة الشعبيّة!
النموّ والفرح معياران للتمييز الروحيّ
إن كان ما قلناه حتّى الآن صحيحًا يكون اختبار إرادة الله في حياتنا هو اختبار نموّ وفرح عميقين، لأنّه اختبار نعم لا يشوبها لا لوجودنا وحياتنا. ولهذا حيث أجد النموّ والفرح الثابتين أعرف أنّني أعيش اختبار مشيئة الله. هذه حصيلة تفكيرنا.
ولكن هذه النتيجة تثير فينا انزعاجًا وشعورًا بالقلق والعديد من الأسئلة. قبل أن أطرح الأسئلة وأحاول أن أجيب عليها يهمّني أن أتوقّف قليلاً عند شعور الانزعاج والقلق هذه. حين عرضت معيار التمييز هذا في رياضة روحيّة قال لي أحد المتريّضين: فرح ولكن بشروط طبعًا! سألته: أيّ شروط؟ قال: لا أعلم، أنتَ قُلْ لي... ليس من السهل علينا الخروج من حذرنا من الله. هذا الحذر هو الّذي يجعلنا نقع باستمرار في الخطيئة لأنّه يدفعنا إلى الرغبة في تملّك البركة، فنحن نخاف أن يحتفظ بها الله لنفسه، وتكون النتيجة أنّنا نسعى إلى سجن الله في تصوّراتنا الضيّقة وبذلك نقطع بأيدينا الشرايين الّتي تنقل الحياة إلينا. نقتل أخانا (رمزيًّا أو فعليًّا) إن هدّد صورتنا عن الله، أو نفقد الثقة أنّ للحبّ مستقبل في عالمنا وننقاد إلى إرضاء الذات ولو كنّا عالمين أن ليس لهذا الموقف من مستقبل، أو نقع فريسة الغيرة والمقارنة لأنّنا لا نصدّق أنّ السعادة هي في اكتشاف التيّار العميق فينا، بل نظنّ أنّها تأتي من الثروة أو من الصحّة أو من الجمال، أو من السلطة، فتصير بركة أخي لعنة لي وفرح أختي حزنًا لي. لأجل هذا نفضّل أن يكون للبركة شروطٌ حتّى "نستحقّها" ونضع لأنفسنا ضمانات تجاه الله.
لنرَ الآن بعض الأسئلة الّتي يطرحها علينا معيار التمييز: سأختصرها إلى ثلاثة: أوّلاً، ماذا تفعل بالتقشّفات وتطلّب إنكار النفس في الإنجيل، ألا يجب أن نطيع الإنجيل بدلاً من أن نسعى وراء المزيد من النموّ والفرح؟ مثلاً، إن كان صوم يونان لا يعطيني فرحًا وسرورًا، هل أرميه ورائي؟ ثانيًا، على الإنسان واجبات تجاه الآخرين لا يستطيع أن يفرّط فيها حتّى ولو كان لا يجد فيها فرحًا ونموًّا، مثل الدراسة أو العمل أو الاعتناء بالأطفال أو الشيوخ أو المرضى. ثالثًا، ألم نتعلّم أنّ البركة تحلّ على ابن الطاعة؟ ماذا لو تعارض معيار الفرح والنموّ مع ما تقوله لي سلطة الكنيسة؟
إنكار النفس والتقشّفات
يحذّر القدّيس أنطونيوس الكبير رهبانه وتلاميذه من ممارسة التقشّفات وأعمال ترويض النفس من صوم وصلاة وما إلى ذلك إن لم يكن هدف تقشّفاتهم ماثلاً أمامهم. لأنّ التقشّف لأجل ذاته لا يوصل إلى شيء بل يوقع في الأوهام وربّما أيضًا في الكبرياء. إن صُمْتَ فاعلم لِمَ تصوم وإن حرمتَ نفسك شيئًا اعلم لِمَ تحرمها ومِنْ أجل مَنْ. حين يتكلّم القدّيس بولس عن حرمان الذات من الملذّات يستخدم صورة المتسابقين الّذين يحرمون أنفسهم من أشياء كثيرة ليفوزوا بما هو أعظم. لهؤلاء رغبة في المجد تصير أمامها الأمور الأخرى نفاية قليلة الأهمّيّة. المهمّ هنا ليس الحرمان بل الرغبة. وهذه قاعدة ذهبيّة: ليست الأشياء السلبيّة الّتي تبني بل الأشياء الإيجابيّة. الحرمان سلبيّ والرغبة الّتي وراءه إيجابيّة، والمهمّ ليس الحرمان بل الرغبة الّتي تعطيه معنى. أصوم لأحقّق شيئًا لأنّ في هذا الشيء فرحي ونموّي. التقشّف وسيلة لا غاية. وإن كنتُ أعيش التقشّف بلا فرح أو بلا بحث ورغبة، فمن المهمّ أن أعرف إن كان هذا عارض يمرّ بسرعة أم مشكلة عميقة. في الحالة الثانية ينصح الآباء بالتوقّف عن التقشّف لمعالجة الوضع، لأنّ التقشّف من أجل ذاته لا يقود إلى الحياة.
أمّا إنكار الذات فما هو إلاّ التخلّي عن مشاريعي الذاتيّة حين لا تخدم مشيئة الله، أي التخلّي عن مشاريعي الّتي تمنعني من أن "أكون". الممتلئ من ذاته لا يُصغي، ومن لا يصغي لا يسمع الله يدعوه إلى الحياة، ومن لا يسمع هذه الدعوة لا يجد التيّار العميق الّذي يقوده إلى الحياة، ومن لا يجد التيّار العميق يبقَ عرضة للتذبذبات. لهذا لا يثبت الممتلئ من ذاته، بل يميل مع كلّ ريح ويفقد ذاته الّتي أراد الحفاظ عليها. أمّا من ينكر ذاته فهو الإنسان الّذي يقبل أنّه محبوب إلى أقصى الدرجات ويتصرّف على هذا الأساس، فيجد نفسه في الله.
ماذا عن الواجبات ؟
هل أتوقّف عن الذهاب إلى القدّاس لأنّني لا أجد فيه فرحًا ونموًّا؟ هل أترك عملي لأني لا أجد فيه فرحًا ونموًّا؟ هل أهمل جدّي وجدّتي لأنّ الاهتمام بهما لا يعطيني فرحًا ونموًّا؟ هل أربّي أولادي على أساس أنّ إرادة الله هي حين يجدون الفرح والنموّ؟ ما أدراك ما الّذي يعتبرونه فرحًا ونموًّا؟
أوّلاً، لننتبه مجدّدًا إلى أنّ ما يهمّنا بالأساس هو الإيجابيّ لا السلبيّ: ليس المقصود "ترك" الواجبات، فالترك سلبيّ، بل المقصود هو اختيار ما أجد فيه المزيد من الفرح والنموّ حين يكون الاختيار متوفّرًا. في بعض الظروف الصعبة قد لا يكون أمامي خيار حقيقيّ. بين عملي المتعب والبطالة ما زلت أفضّل عملي، وإرادة الله هنا هي أن أختار الحياة بصعوباتها على الاستسلام لليأس والكآبة والشكوى، واختبار إرادة الله هنا هو اختبار الثبات في وجه الصعوبات ورفض الاستسلام. ليس لهذا الاختبار في هذه الحالة مذاق لطيف ولكنّه ما زال اختبارًا ينمّي ويغذّي. بهذا المعنى هو اختبار فرح، لأنّه مقاومة حتّى الدم ضدّ الحزن.
نجد أحيانًا أشخاصًا يختارون حقل دراسة أو عملاً لا يحبّونه وذلك إرضاء للعائلة أو جريًا على العادة أو خوفًا من التعبير عن رغبتهم الحقيقيّة. هؤلاء لا يختبرون من خلال اختيارهم هذا إرادة الله. فهل يجب أن يتركوا ما بدأوه لكي يطيعوا إرادة الله؟ ربّما. كثيرًا من الأحيان يجد الإنسان تدفّق الحياة فيه حين يقوم بتغيير جذريّ. ولكن ليست هذه بالضرورة حالة الجميع. اختبار إرادة الله هو اختبار في الحاضر لا في الماضي، والله يبني معنا مستقبلنا انطلاقًا من ماضينا. لذلك تصير اختبارات الماضي حتّى السلبيّة منها مادّة لبناء الحياة مع الله.
ثانيًا، حين لا أستطيع تغيير الظرف الخارجيّ أرى كيف يمكنني أن أغيّر طريقة تصرّفي معه. أن أختار الفرح والنموّ قد يكون أحيانًا عمليّة داخليّة: أختار أن أتعامل مع الأمور من منطلق إيجابيّ يعطي الحياة. مثلاً: لا يمكنني أن أغيّر واقع أنّي ولدتُ في المكان الّذي ولدتُ فيه، ولكنّي يمكنني أن أختار أن أسجن نفسي في الغضب والحسرة أو أن أجد منطلقات الحياة في المكان الّذي أنا فيه.
ثالثًا، التمييز الروحيّ هو للكبار والناضجين لا للصغار. الصغار يحتاجون إلى توجيهات واضحة، إلى شريعة. لذلك لا بدّ من أعطي صغاري توجيهات حازمة لكي يستطيعوا أن يبنوا حياتهم. ولكنّي لا أقوم بواجبي تجاههم بما فيه الكفاية إن لم أدلّهم تدريجيًّا على حرّيّتهم الّتي يعطيهم إيّاها الله بأن يكونوا... فقط أن يكونوا. كذلك عليّ أحيانًا أن أتعامل مع نفسي، مثلما أتعامل مع الأطفال، أي لا بدّ أحيانًا من أن أعطي لنفسي توجيهات واضحة لكيلا تتبع اختياراتي تقلّبات مزاجي بدلاً من أن تنبع من رغباتي العميقة الّتي فيها أختبر إرادة الله.
ابن الطاعة تحلّ عليه البركة
هذا ما نقوله من البداية: مَنْ يُطِعْ (أي من يسمع) يختبرْ البركة (أي يكتشف التيّار العميق الّذي يدلّه إلى الحياة)، لهذا فالطاعة هي لله وحده. ولكن ماذا عن الطاعة للبشر؟ خصوصًا تلك الّتي تتمّ باسم الله، أي الطاعة لرجال الدين وللسلطة الكنسيّة؟ تعلّمنا الكنيسة أنّ هذه الطاعة مفيدة جدًّا لمعرفة مشيئة الله لأنّ الإنسان ينتصر من خلالها على ذاته وعلى مخاوفه ويسمع من خلال مرشده الروحيّ صوت الله الّذي يدعوه إلى الوجود. ولكن لا بدّ هنا من الانتباه إلى المسائل التالية:
أوّلاً، تشدّد الكنيسة على أولويّة الضمير، أي أنّ على المؤمن أن يتبع ضميره في قراره النهائيّ لأنّه هو المسئول الأخير عن قراره.
ثانيًا، لا بدّ للمرشد الروحيّ أو أب الاعتراف أن يثق ثقة لا متناهية بالله فلا يخاف من حرّيّة ابنته الروحيّة أو ابنه الروحيّ، بل لا يخاف إن سلكا طريقًا قد يكون مسدودًا لأنّ الله يفتح الطرق أمامنا، بل ليتذكّر أنّ واجبه الأساسيّ هو أن يساعد الشخص على أن يختبر إرادة الله، فلا يجعل من نفسه محور الحياة الروحيّة، بل ينسحب ليدع الشخص أمام الله. أبي الروحيّ جدير بالطاعة حين يعلّمني كيف أميّز بدوري ويجعلني مستقلاًّ عنه لكي ألتقي بخالقي بنفسي.
ثالثًا، أبي الروحيّ جدير بالثقة والطاعة حين يعكس لي حبّ الله الّذي لا يسجنني في مشروع لا يعطيني حياةً ولا نموًّا. لا يجوز أن أتزوّج من فلانة بناء على رأي "أبونا" أو أن أتخصّص في المجال الفلانيّ بتاء على تمييز مرشدي الروحيّ. أن أطيع في هذه الأحوال يجري ضدّ إرادة الله ولا يعطيني أيّة بركة.
هل قلتم مشيئة الله ؟؟؟
كثيرًا ما نقع فريسة كلماتنا. نتكلّم على مشيئة الله وكأنّها شريعة خارجيّة مستورة علينا اكتشافها، مكتوبة علينا وعلينا طاعتها، أو بالعكس نظنّ أنّ إرادة الله هي في الواقع إرادتنا ونسقط على الله رغباتنا ونجعل من اختبار الله مجرّد إحساس ممتع يخفي عن أعيننا أحزاننا وتطلّبات عالمنا، وكأنّنا نجعل من الله شرطيًّا وإمّا صديقًا خفيًا (وربّما كليهما في تواتر وازدواجيّة)، نسجنه في الخارج أو نسجنه في الداخل، ولكن في كلّ الأحوال نفضّل سجنه. لله مشيئة مختلفة عن مشيئتي، لأنّ مشيئة الله هي أنا: الإنسان الّذي خلقه الله ووعده بالحياة، وأنا مشيئتي ألاّ أكون أنا ولكنّي حين أهرب من ذاتي أهرب من وعود الله. اختبار مشيئة الله هو اختبار الخلاص، أي اختبار يجعلني أريد أن أكون أنا وأتخلى بفرح عن أن أكون غير أنا. هو اختبار غفران لأنّ ظلام الماضي يصير بنوره نورًا، هو اختبار شفاء لأنّ جراح الماضي تصير مصدر ثقة وثبات. هو أيضًا اختبار رسوليّ لأنّي أعي وحدتي العميقة مع الخليقة بأسرها وأرى نفسي معنيًّا بكلّ ما يعنيها فيصير وعيي مثل رسالة أحملها إلى الآخرين. حين نقول مشيئة الله، نحن نعني هذا الاختبار.