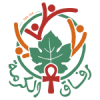بقلم سليمان شفيق
(1) من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر (السيد المسيح)
لعل أصعب الأسئلة.. هي التي نجيب عليها عشرات المرات بشكل يومي، نعيشها، وربما لا ندركها.. أو ندركها ولا نجيد التعبير عنها. هل سأل أحدنا يوماً نفسه.. ما هو تعريف الإنسان؟ كنت دارساً للاهوت الأدبي.. وطرح الأب نادر ميشيل اليسوعي هذا السؤال على الدارسين والدارسات، وتعددت التعريفات ولكن الكل أجاب من خلال معلوماته دون أن ينظر إلى نفسه، ويجيب من خلال إدراكه لذاته، والملفت للنظر أن كلمة "جسد" غابت عن كل التعريفات، ولذلك حينما كتب الأب نادر التعريف : "جسد مجنس (ذكر – أنثى)، يتكلم (يعيش في محيط الكلمة)، (علاقي)، أي لا يستطيع الحياة بدون علاقة مع الآخر". اندهش أغلب الحضور ونظروا لبعضهم البعض، وربما تحسس البعض أجسادهم!
لذلك عاودني ذات الارتباك عندما طُلب مني الكتابة عن العنف، فإن كتبت عن خبراتي فقط.. سوف أقع في براثن الذاتية، وإن استحضرت كتابات الآخرين فحسب فسوف أسقط في فخ الموضوعية الشكلية، وألقي بثقل الإجابة على السؤال على الآخرين! ولذلك سوف أمزج بين المنهجين في محاولتي فك شفرة أسطورة العنف ذاتياً وموضوعياً.
بداية سوف أبدأ بسؤال.. وتمرين.. إذا كان الإنسان جسد مجنس.. يتكلم، لا يستطيع أن يعيش سوى في علاقة مع الآخرين، فما هو إدراككم لتجسد العنف؟ هل مارستم العنف الكلامي، أو الفكري، أو الجسدي؟ ولماذا وكيف؟ وإلى أين؟
أبدأ بنفسي، كنت مقاتلاً في صفوف حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) منذ عام 1978، وحينما حدث الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو/حزيران 1982، تقهقرت مع فصيلتي من صور في جنوب لبنان إلى بيروت لصد العدوان، وتمركزنا في منطقة المتحف، وفي مطلع شهر أغسطس، وفي اليوم الثمانين للحصار، كان الجيش الإسرائيلي يمطرنا بكافة أنواع النيران من الجو والبحر والبر، ويحاول اختراق المتحف لكي يصل إلى عمق بيروت الغربية، لمدة أسبوع كامل، وأبلينا بلاءً لا نظير له. كنت لم أتذوق النوم لليوم الثالث على التوالي، لا أسمع سوى أزيز الطائرات، وهدير المدافع، وأنين الجرحى وحشرجة الأنفاس الأخيرة للموتى، ولا أشم سوى رائحة اختراق حريق الآليات بالأجساد، ولا أري سوى الهدف المعادي الذي يقترب مني، وغطت لغة القتل على صوت الضمير الإنساني.. وحينما صدر إلينا القرار بوقف إطلاق النار، ومنح كلانا الفرصة للملمة جراحه، وبقايا أحبائه، شرعت في جمع أشلاء ثلاثة من رفاقي، تذكرت كم ودعت في الحرب من أحباء، في كل مرة كنت أتعرف على أسمائهم الحقيقية، ودياناتهم من شواهد قبورهم، والشواهد عادة تنطق بما تيسر من الحقيقة، ففي مقابر المسيحيين اللبنانيين إبان الحرب الأهلية وما تلاها بقليل.. تقرأ: "الشهيد.. استشهد على يد الفاشية الإسلامية أو الشيوعية أو الفلسطينية"، وفي المقابل تقول شواهد قبور المسلمين: "الشهيد... استشهد على يد الفاشية المسيحية أو السورية أو..." وهكذا الشيعة، والدروز و...، كنت ألملم اللحم البشري المحترق في المتحف، وأنا أتذكر مقالاً كتبته في صحيفة النداء اللبنانية عام 1980 بعنوان "معذرة أحبائي الشهداء.. كلنا فاشيون".
وفي المساء ذهبت إلى صحيفة المعركة – صوت الصامدين في بيروت – وكنت أمارس فيها الكتابة في أوقات السلم.. وجدت رئيس التحرير الشاعر الكبير محمود درويش، أخرج لي قصيدة كتبها مشاركة مع الشاعر الراحل معين بسيسو، بعنوان "رسالة إلى جندي إسرائيلي".. توقفت عند مقطع لمسني بشدة : "ضحية قتلت ضحيتها" سألني لماذا؟ قلت لأني جيلي تربى على الأشعار التي تقول : "الحق هو القوة، والحق هو المدافع، والحق من غير قوة، عمره ما يلقى مدافع، اضرب تعيش.. اضرب تسود، اضرب يدين لك الوجود"!!
أجاب درويش متذكراً الشاعر اللبناني الكبير خليل حاوي قائلاً: لقد انتحر خليل حاوي حينما رأى الدم يطمس معالم القصيدة، وأراد الشاعر أن يخرج من المأزق فأضاف: لقد كنتم شجعاناً في تصديكم للعدوان، همست له قائلاً: أستاذي، هذه الشجاعة من وجهة نظري هي أرقى درجات الجبن، تساءل كيف؟ فقلت له: أنا أخاف الموت في الخندق فأتقدم الصفوف، أخاف من الآخر فأقتله، حتى أنني أخاف أن أنظر إلى عيون من أواجههم في الميدان! قال: حقا لقد انتصر المسيح حينما هزم سبارتاكوس.
(2) لقد انتصر المسيح حينما انهزم سبارتاكوس (الشاعر الفلسطيني محمود درويش)
خرجنا من بيروت في الأسبوع الأول من سبتمبر 1982، بعد أن عقد الراحل أبو عمار اتفاقية مع إسرائيل. ذهبت إلى الاتحاد السوفييتي السابق لاستكمال دراستي، ولم تفارقني عبارات عاشت في قلبي، "معذرة أحبائي الشهداء.. كلنا فاشيون"، و"ضحية قتلت ضحيتها". لم أشك يوماً في عدالة قضية الشعب الفلسطيني، ولكن رويداً.. رويداً صرت متيقناً أن العنف مهما كانت مسمياته لن يحرر أرض ولا إنسان.. قررت عدم استخدام العنف، وانضويت تحت لواء المجموعات الفلسطينية التي تناضل من أجل السلام، وللأسف أغلبهم تم اغتيالهم فيما بعد مثل الشهيدين: عصام سرطاوي وعز الدين قلق، ولكنني كنت أشعر أن الاستشهاد في هذا الميدان أكثر نبلاً من الاستشهاد في ميدان العنف.
انتهت دراستي 1988، ناضلت في صفوف دعاة السلام حتى اتفاقات أوسلو عام 1993، كنت منسقاً للشراكة التي كانت تجمع بين مركز المعلومات البديلة الفلسطيني ومركز ابن خلدون ومركز كارتر للسلام. ومنذ عام 1994 شاركت في تدريب الكوادر الشابة في منظمة التحرير الفلسطينية على آليات صنع السلام. وفي عام 1996 سافرت إلى القدس، للمشاركة في تدريب اللجنة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات، وبدأت المعركة الانتخابية، وكانت حركة حماس ترفض الاتفاقية، وبالتالي، لم تشارك في الانتخابات. وصبيحة يوم الاقتراع كنت منسقاً لمجموعة لمراقبة الانتخابات في قضاء الخليل مكونة من 20 مراقباً من خمس جنسيات. وفجأة ارتعش جهاز اللاسلكي وسمعت صوت استغاثة، فالمستوطنون المدججون بالسلاح يحاصرون مقر اللجنة العليا بالخليل ويرفضون إجراء الانتخابات، تنادينا وأسرعنا إلى المقر الملاصق للحرم الإبراهيمي، أرغمنا المستوطنون على الانبطاح أرضاً، ووضعوا أقدامهم على ظهورنا، وامطرونا بوابل من الشتائم، خاصة الأمريكيين منا. كدت أن أفقد كل ما تكونت عليه في السنوات الماضية عن السلام تحت أقدام المستوطنين، وشعرت بكل أنواع الذل والاحتقار، وتصارع في داخلي: (الحق هو القوة) و(ضحية قتلت ضحيتها). رمقت بعيني شعاراً مكتوباً على جدران الحرم الإبراهيمي: (السلام أو الموت)، انتابتني رعشة قوة وسرى داخلي تياراً باطنياً دفعني للوقوف هاتفاً بذلك الشعار، ردد رفاقي خلفي (السلام أو الموت)، كانت حناجرهم أقوى من فوهات بنادق المستوطنين، توارت الأسلحة وجاء الرئيس كارتر وحررنا، وأجريت الانتخابات في حراسة الجيش الإسرائيلي.
انتهت المعركة الانتخابية. وفي بيت الشرق بالقدس، استقبلنا فيصل الحسيني والنائبة المقدسية حنان عشراوي، نوهت عشراوي لشجاعتنا في مواجهة جحافل المستوطنين، قلت: الشجاعة أيضاً هي أرقى درجات الخوف، ولكن في هذه المرة هي أرقى درجات الخوف الإيجابي على السلام.
قطع: سألت فيصل الحسيني عن توقعاته للمستقبل، قال: "لن يهدأ بال اليميني الديني الصهيوني إلا بعد أن يستدرج اليمين الديني الحمساوي والجهادي لمستنقع الدم من أجل إفشال السلام"، وصدقت نبوءة الرجل.
(3) قد آن يا شاعر للقلب الجريح أن يستريح (الشاعر المصري نجيب سرور)
كان لابد أن أعبر سفر الخروج من بيروت إلى أرض الميعاد في القدس، في رحلة تزيد بالزمن عن رحلة عودة "عوليس" في أسطورة الإلياذة والأوديسة، وها أنا أصارع في نفسي مع الباحثين عن الحقيقة حول ماهية العنف، فهل يمكنكم أن تعانون معي، ولو لساعة واحدة.
هناك مدرستان لرؤية ماهية العنف، مدرسة تقول بالعنف الفطري وأخرى تؤكد على أن العنف مكتسب، نتيجة عوامل وظروف خارجية، هناك العالم "روبرت أدري" القائل بأن البشر قتلة بطبعهم، ويشير إلى أن البشر الأوائل البدائيون شأنهم شأن الحيوانات المفترسة. ويضيف أحد أبرز معتنقي مبدأ "الداروينية الاجتماعية" "هيربرت سبنسر" قائلاً: إن البقاء في صراع الوجود للأصلح، حيث كان المعتقد أن التطور العرقي أو تاريخ تطور النوع يقدم الذخيرة البيولوجية الأولى للانتقاء الطبيعي، وارتبط ذلك بأن العنف مركب غريزي فطري طبيعي وسمة للجنس البشري.
وفي مواجهة ذلك كتبت الباحثة "إشيلي مونتابو[1]" في دراستها، حيث فندت إشيلي تلك الإدعاءات مؤكدة على أن التطور الأول للإنسان ارتبط باللاعنف، وأن أجدادنا الأولين لم يمارسوا العنف من أجل إشباع نفسي أو فطري أو غريزي بل من أجل تأمين البقاء للنوع الإنساني وسد الحاجات الجسدية والاجتماعية.
وفي بحث موسوعي بجامعة هارفرد 1994 بعنوان "أساطير ونماذج"، أكد العالم "جون لارسن" على أن العنف صفة مكتسبة، وأن العدوان ينتج عن التأهيل والتنشئة والإحباط، ولم تنكر هذه الأبحاث الأسباب الفسيولوجية للعنف بل أكدت على ضرورة التمييز بين الاكتساب والعادة، حيث يعتمد اكتساب سلوك القتال على عوامل كيميائية حيوية، أما عادة القتال فتعتمد على التعلم السابق، ودللوا على ذلك بأن السلوك الهجومي للبشر يبدأ فكراً ثم كلاماً ثم حركة.
وتكاد تتطابق خبرتي مع رؤية لارسن ولكن.. لماذا العنف؟
للأسف أن الأغلبية من الآباء المعترفين بالعنف الفطري تنغلق مشاعرهم على عقدة الذنب الثقيل التي تعاني منها الحضارة الغربية كما تقول إشيلي، ويضيف لارسن في ذلك الاتجاه قائلاً إن ما ارتكبته هذه الحضارة من عنف وحروب ودماء يجعل بعض جنرالاتها مثل "الجنرال فون برنهاردي" يكتب قائلاً :إن الحرب ضرورة بيولوجية.
في عالمنا المعاصر صارت البنية التحتية للعنف تكمن في إعادة إنتاج العنف عبر تأويل النص المقدس أو التاريخ الإنساني بشكل ديناميكي سواء في الثقافة الغربية أو الشرقية، بما يضمن استمرارية العنف من جيل إلى جيل، وتجسيده في المواقف والمعتقدات الثقافية بأشكالها المختلفة. وهنا يصبح العنف مثل "الفيروس الكامن" تحركه وتنشطه وتشرعه وتضفي عليه قدسية أنماط الثقافة السائدة في هذا المجتمع أو ذاك، ويتم استدعاء "الفيروس الموروث الكامن" ضمن ثالوث إيماني ثقافي جمعي مكون من (الأنا – الآخر – العالم). ومن هنا تعتمد تلك الإشكالية العنيفة على الإيمان بعدالة العنف!
وترتبط سيرورة هذا الإيمان بالدعاية والإعلام والبحث العلمي ومعطيات التأويل الديني فقهياً ولاهوتياً، هؤلاء الذين يبررون الحرب ويشرعونها بل ويضفون عليها قدسية، وكما يذكر العالم الأمريكي "فان كريفيليد"[2] بأن "الحرب على المستويين الفردي والجماعي كلاهما مثل القلب الذي يعتمد على الإيمان الثقافي بالشرف والواجب والشجاعة والإخلاص"، وتعتلي قمة الإيمان الثقافي الإيمان الديني بأن القوة هي الحق، وهكذا لاحظت الباحثة "أرزيولا فرانكلين" أن "الحرب تولد الحاجة إلى عدو معقول وطويل الأجل".
(4) الحرب تولد الحاجة إلى عدو معقول وطويل الأجل (الباحثة الأمريكية أرزيولا فرانكلين)
ولكن لماذا منطقتنا بالذات؟ هناك ثلاثة مستويات لمحاولة الإجابة على هذا السؤال:
المستوى الأول: في حوار مع المفكر المصري محمد سيد أحمد[3] قال: خسر العرب بسقوط الاتحاد السوفيتي صديق، وخسر الغرب الأمريكي عدو. وفكرة خسارة العدو يكاد يجمع عليها أغلب علماء الاستراتيجية الامريكيين وفي مقدمتهم "بريجينسكي[4]" مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، ولم يكن هناك عدو أكثر استعدادية وجاذبية من المتشددين الإسلاميين.
المستوى الثاني: على أثر سقوط الاتحاد السوفييتي نشبت 88 حرباً أثنية ودينية في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق، وبرزت كتابات "فوكوياما" حول نهاية التاريخ و"هنتجنتون" حول صراع الحضارات، واستدعت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية كتابات سابقة نشرت في مطبوعات البنتاجون، حول القوة الخلاقة والفوضى الخلاقة. وعلى أثر الاستقرار النسبي في منطقة البلقان ونجاح الثورة البرتقالية في عدة دول في أوروبا الشرقية، تطلع المجمع العسكري الصناعي لمنطقتنا. وأثناء دراستي التي امتدت ما يقارب العشر السنوات (1988-1998) للملل والنحل والأعراق والأقليات في منطقتنا اكتشفت أن المنطقة العربية تسبح في بحر من التناقضات التناحرية بين الأغلبيات العربية والمسلمة، وحوالى (412) أقلية عرقية ودينية وثقافية في كل البلدان العربية وتتجاوز نسبة هذه الأقليات إلى السكان 28%، بل واكتشفت أن الصراعات بين الأغلبيات والأقليات في منطقتنا استنذفت تكلفة مادية وبشرية من عام 1948 إلى عام 1998، تشكل أكثر من عشرة أمثال ما تكلفناه في الصراع العربي الإسرائيلي في ذات الفترة. وكما يقال الأرقام عنيدة[5]: دفعنا في الصراع العربي الإسرائيلي 120 ألف ضحية وهجر وشرد حوالى ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، وخسرنا حوالى الأربعين مليون دولار. وفي حروبنا الداخلية خسرنا أكثر من مليون ضحية (أكثر من 60% منهم في حروب صدام حسين ضد الأقليات الكردية والشيعية والحرب مع إيران والكويت، كما تتجاوز الخسائر البشرية في الحرب اللبنانية الأهلية وحدها خسائرنا البشرية مع إسرائيل حيث بلغ عدد الضحايا من اللبنانيين والفلسطينيين 136 ألف ضحية). أما المهجرين والمشردين فقد بلغوا 12 مليوناً، وتجاوزت خسائرنا المادية في تلك الصراعات 140 مليار دولار، مع ملاحظة أن تلك الأرقام والإحصائيات لم يضف إليها الصراعات التي نشبت أخيراً في العراق بعد الغزو الأمريكي، وهكذا كانت منطقتنا مؤهلة للعنف أثنياً ودينياً أكثر من أي منطقة أخرى في العالم مثلما تؤكد تقارير جماعة حقوق الأقليات بلندن (mrg ).
المستوى الثالث: الإرث الثقافي والمعتقداتي والأيديولوجي للعنف بكافة أنماطه الثقافية والعرقية والدينية، ذلك الإرث الذي أهلها لأن تكون المستهلك الأساسي لمبيعات الصناعات العسكرية والسلاح بنسبة بلغت 37%[6] من تلك المبيعات في العالم، إضافة لكونها تمتلك أكبر احتياطي للطاقة والنفط.
وغني عن التعريف أن منطقتنا مهداً للرسالات الإبراهيمية الثلاثة (اليهودية – المسيحية – الإسلام)، وعلى مر التاريخ شهدت عنفاً دينياً تم تقديسه وترسيخه في الوجدان الروحي الشعبي الجمعي، خاصة ما تلا الانقسامات في المسيحية بعد مجمع خلقيدونية والحروب التي امتدت من عام 451م ولازالت أوزارها الفكرية واللاهوتية العنيفة تتفاعل حتى الآن، وكذالك ما سمي بالفتنة الكبرى بين الشيعة والسنة منذ العقد الرابع من القرن الأول الهجري، وكما يقول الأستاذ الدكتور قدري حفني[7] "بخصوص تأثير الدين على السلوك لم يكن مستغرباً أن يلجأ البشر على اختلاف موازعهم لالتماس السند الديني في تصرفاتهم إياً كانت، فوجد يهود يلتمسون في آيات العهد القديم ما يبرر لهم القتل وسفك الدماء دون تمييز رغم الآيات التي تحرم القتل والسرقة والنهب، بل وتنهي حتى عن مجرد التفكير في الشر وتحذر من إيذاء الغرباء. ووجدنا يهوداً لا يعترفون بالدولة العبرية ويناصرون الحق الفلسطيني عبر تأويلات ونصوص العهد القديم أيضاً". ويستطرد قائلاً: "وبالنسبة لنا كمسلمين فقد وجدنا من يعتبر أن كافة آيات التسامح والمسالمة قد نسخت ولم يعد أمام المسلمين سوى قتل من يخالفه في العقيدة". ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لنا كمسيحيين، إذ أطل العنف برأسه بعد قتل بعض المسيحيين الأوائل للفيلسوفة السكندرية " هابتشا"، والعنف الذي تلا مجمع خلقيدونية 451 م مروراً بالحروب الصليبية وعنف القرون الوسطى، وصولاً إلى العصر الحديث واللاهوت الاستعماري. بل وهناك لاهوت حض على التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا (راجع كتابات الأب وليم سيدهم اليسوعي حول لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا).
وفي المقابل هناك الملايين من الشهداء المعترفين المسيحيين شرقاً وغرباً الذين بذلوا حياتهم من أجل الاحتفاظ بالنقاء المسيحي، والتجسد في البشارة بالمسيح الفقير والمتألم والأعزل.
نسوق جميع تلك المعطيات في مواجهة مدرسة منحازة في تحليلاتها للعنف المرتبط بالدين. فأصحاب هذه المدرسة مع احترامنا لهم ولأدواتهم العلمية يكيلون بمكيالين، حيث أنهم لا يرون القشة التى في أعينهم حينما ينظرون إلى القشة التي في عيون الآخرين، أي أنهم لا يرون أي سلوك عنيف يرتبط بالتأويلات التي تنتسب إلى أبناء ديانتهم، ويرونه جلياً في التأويلات التي تنتسب لأصحاب ديانات الآخرين!
وأكثر من ذلك أن أصحاب تلك المدارس المنحازة صاروا نجوماً في السموات المفتوحة للبث الفضائي، حيث يتم تسليع الدين عبر مشايخ وقساوسة ( (sms . وساعد على تعاظم هذة الظاهرة أنه من بين 1008 قناة تليفزيونية فضائية في العالم هناك 381 قناة دينية عربية أو تبث بالعربية للمنطقة العربية، 71% منها إسلامية 29% مسيحية أغلبها ينفي الآخر ويسيد ثقافة الخرافة والعنف.
ومن المفارقات أيضاً أن هذا التشوه قد طال حتى بعض المؤسسات التي بطبيعتها ترتكز على مواثيق حقوق الإنسان، فنجد منها منظمات مسيحية وأخرى إسلامية، وكلاهما لا ينفيان بعضهما البعض فحسب، بل يتفقان على معاداة ونفي أصحاب الديانات الأخرى مثل اليهود والبهائيين، ومصادرة الإبداع وما أكثر الأمثلة على ذلك. وربما أخطر إفراز لتجليات ثقافة العنف الإيجابي أو السلبي المتسربل بعباءة الدين هو تقديس ما يسميه د/قدري حفني "الروحانية التدميرية" عبر ترسيخ العمليات الانتحارية بمسميات مختلفة مثل الاستشهادية، وفي حالتنا المسيحية فهم يكرسون ثقافة العنف ضد الذات (ولا أقول الجهاد الروحي) بل ما يؤدي إلى الانسحاب والاغتراب عن العالم بمعناه الإيجابي الكامن في التجسد والرسالة.
(5) قد يكون ديستويفسكي قاسياً ولكن مجتمعه كان أكثر قسوة (المفكر الروسي "بيلينسكي")
كنت وسأظل من دعاة السلام ولكنني في الآونة الأخيرة.. أقوم بمراجعة جدية لهذا المفهوم وتلك الحركة في جدلية علاقتهما بواقعنا، خاصة بعد أن تأملت في كتاب الصحفي البريطاني "جدرين باروز" الصادر عام 2002 وعنوانه "صناعة السلاح"، والذي استخدم فيه تعبير "المجموعة القذرة" مشيراً إلى مجموعة الدول التي تتصدر صناعة السلاح وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ثم فرنسا وبريطانيا ثم هولندا، حيث تستأثر تلك الدول بتصدير 85% من السلاح في العالم (تحتل اسرائيل المرتبة الثانية عشر في القائمة). والملفت للنظر أن الدول الأربعة الأولى التي تتصدر القائمة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي المنوط به "حماية السلام العالمي". والأكثر غرابة أن أصحاب القائمة هم من أكثر الدول التي تدفع بسخاء تمويلات تقترب من 59% من حجم تمويلات مؤسسات السلام والتنمية والثقافة المدنية في العالم!! وتوجه هذة التمويلات إلى مناطق الاقتتال الدموي.
وبالطبع هناك تمييز داخل مؤسسات ثقافة السلام، ولعلنا نتذكر بإجلال داعية السلام الأمريكية الجنسية اليهودية الديانة والبالغة 23 عاماً "راشيل" والتي سحقتها جرافة إسرائيلية خلال احتجاجها على الممارسات الاسرائيلية في رفح مارس 2003.
أعلم أن ثقافة العنف لها بنيان مادي ومعنوي أسطوري ويقف خلفها تجار السلاح ومؤسسات البحث العلمي والإعلام وبعض رجال الدين، وأن حركات السلام لا سند لها إلا الله سبحانه وتعالى.
ولكن المنهج والأجندة الغربية لبناء ثقافة السلام مع كامل تقديري لهما... لا علاقة لهما بواقع مجتمعاتنا العربية فتلك المفاهيم العظيمة والآليات المحترمة والأساليب الرصينة تخاطب بالأساس مواطن غربي مدني تمت تنشئته بطرق مختلفة. أما مجتمعاتنا ذات الثقافة التي تمزج بين العنف وصورة البطل المقدس في تضافر إيماني بين ثالوث الثقة (الأنا – المجتمع – العالم) حيث يتم من خلالها تغيب الوعي كسبيل لاحتلال السماء لا للعدالة على الأرض واستباق الملكوت.
ولكن وكما يقول برنارد شو: "قد نكون جزءاً من المشكلة ولكننا بالتأكيد جزءاً من الحل". إننا بحاجة مبدئية لإعادة النظر في مؤسسات صناعة الضمير والكلمة في مجتمعاتنا، خاصة الدينية منها. حيث أن الخطاب الديني الأخروي الإسلامي والمسيحي هما الآن "حصان طروادة"، الذي من خلاله تخترقنا ثقافة العنف. ولعلنا ندرك أن الإصلاح الديني بالغرب سبق الإصلاح الثقافي ومهد الطريق للإصلاح السياسي والاجتماعي. وهنا والآن، نتذكر الإصلاح الإغناطي، وكيف أن الروحانية الإغناطية تواكبت مع روح الحداثة والنظريات العلمية خاصة الكوبرونيكية، وامتدت بمرسليها شرقاً وغرباً انطلاقاً من مركزية جدل العلاقة بين الله والإنسان على أرضية الحداثة، وتتطلعت على خطى كولومبوس للعالم الجديد، وبنت بالروح صيغة المدرسة الروحية المدنية كآلية لإصلاح التعليم ومدنيته وعلمنته، فصارت المدرسة هي الإطار الإصلاحي لسر التكوين والتربية لدى اليسوعيين. ولعلنا لابد أن نطرح على أنفسنا الاجتهاد من أجل عصرنة ما اكتشفه إغناطيوس في رياضاته الروحية منذ القرن السادس عشر ولازال يعيش فينا حتى الآن. فإن كان العنف يبدأ فكرة ثم خطاباً ثم سلوكاً لنفي الآخر، فلعلي أطرح عليكم الآن مفهوم "الافتراض المسبق بالرياضات الروحية" كسبيل لتفهم القريب وكيفية الحوار معه ولو بالاختلاف. نحن أيضاً بحاجة للاجتهاد في مفهوم نص "المبدأ والأساس الإغناطي" حتى يتسنى لنا تأسيس ثقافة لعدم الانحياز، بحيث تكون هذه الأسس الروحية وغيرها هي البنية الأساسية للتنشئة والتربية خاصة للأطفال من مختلف الديانات والطبقات.
إن التحرر يبدأ من الداخل كما أن العنف يبدأ من الداخل، لقد علمتني خبرتي الروحية المتواضعة مع رفاقي اليسوعيين أن ثقافة عدم الانحياز المرتكزة على التجرد الروحي الموضوعي هي الطريق للحرية الداخلية والسلام الداخلي، السبيل الحقيقي للإنسان في مواجهة ثقافة الانحياز للعنف. وهي تحتاج لمسيرة تبنى على التكوين الحر المعاش، ومن ثم فالسلام ينبع من الداخل في الصراع مع العنف الداخلي. وبذلك فالسلام ليس ثقافة علمية ونصوص تدرس، بل هو مسيرة تكوين ونعمة واختيار. هذا هو السلام غير المنحاز الذي يعلو كل فهم، السلام الذي يتجاوز مخاوفنا واضطراباتنا، هذا هو ميراث السلام الذي تركه لنا السيد المسيح وهو وديعة الإيمان الحقيقية التي لابد وأن نعود إليها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..
[1] "عودة إلى الخطيئة الأولى" - من كتاب الإنسان والعدوان – جامعة أكسفورد 1968.
[2] لمزيد من التفاصيل، راجع: مارتن فان كريفيلد، التكنولوجيا والحرب من 2000 سنة قبل الميلاد وحتى الآن، نيويورك 1989.
[3] صحيفة الأهالي القاهرية، لسان حال حزب التجمع، 3 يناير 1992
[4] بريجنسكي، محاضرات غير منشورة في مركز كارتر للسلام، ضمن دورة تدريبية، أغسطس 1992
[5] لمزيد من التفاصيل راجع موسوعة الملل والنحل والأعراق، د. سعد الدين ابراهيم، مطبعة الأمين – القاهرة، 1995، وتقرير الملل والنحل والأعراق مركز ابن خلدون 1989، رئيس التحرير سليمان شفيق.
[6] انظر تقرير السلاح والديموغرافية العربية، حولية دراسات استراتيجية، مركز كارتر للسلام، عدد ديسمبر 1966.
[7] ورقة بعنوان الروحانية التدميرية – غير منشورة – ندوة “الروحانية بين التدين الشعبي والمؤسسات الدينية الرسمية في عصر العولمة ” مايو 2008- مركز الجزويت الثقافي – كنج مريوط – الإسكندرية.