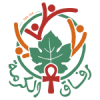بقلم الأب أوليفر بُرج – أوليفييه اليسوعي
لا يمكن أن يعيش المرء بدون أن يتسبب في ألم لأحد الناس أو أن يتسبب آخر في ألم له، فالألم والجرح جزء لا يتجزأ من واقعنا اليومي ومن علاقاتنا. وكما أن الطفل لا يتعلم المشي بدون أن يقع ويُجرح ويتألم، فهكذا لا يمكن أن نعيش علاقاتنا بدون أن نقع ونتألم أو نؤلم الآخرين ونجرحهم. كيف يمكن إذاً قبول الذكريات المؤلمة وشفاؤها؟
قبول الذكريات
إننا لا نحب أن نتذكر ما يؤلمنا! وإن استمعت إلى كبار السن يتحدثون عن الماضي فستظن أنهم لم يعيشوا إلا خبرات ممتعة وجميلة، إذ تبدو حياتهم مثالية، ذلك لأن خبراتهم المؤلمة ولا سيّما جروحهم العميقة قد طُمرت في أعماقهم. ولكن هناك من الألم ما يبني ونحن نحتاج إلى قبوله ومواجهته. إن شعرت مثلاً بآلام في صدري، فرد فعلي واحد من ثلاثة. قد أخشى من مدلول هذا الألم على صحتي وأختار أن أنكر وجوده فلا أفعل شيئاً نحو العلاج؛ أو على العكس أرتبك وأطلق العنان لخيالي، فأتوهم أنني مصاب بذبحة صدرية حادة أو سرطان في الرئة ولن يساهم قلقي إلا في تدهور حالتي الصحية. وإنكار الألم أو الارتباك بسببه سيّان، فالاثنان يمنعانني من حسن التصرف. أمّا الموقف الثالث فهو الاعتراف بألمي واستشارة طبيب لمعرفة سببه، والقلق في هذه الحالة قلق إيجابي لأنه يحثني على التصرف بحكمة واتزان.
إن تذكر ما يؤلمنا يحمل معه الألم. وما أشد رغبتنا في دفن ذكرياتنا المؤلمة ونسيانها، ولكن هيهات؛ فهي تبقى حيّة – وإن مدفونة – فتتسلط علينا وتسكننا كأشباح منزل مهجور وتؤذينا أبلغ أذى. وإن ظلت الذكريات مطمورة وغائبة عن وعينا؛ فهي في الواقع تعمل في اللاوعي بكل هدوء، وليس لنا أي تحكم فيها وفي الدور الذي تلعبه في علاقاتنا. أمّا إن قبلنا أن نتذكّرذكرياتنا المؤلمة وأن ندخل في حوار معها فسنكتشف أننا لسنا بحاجة إلى نسيانها، لأنه بعد شفاء ذكريات هذه الجروح تصبح علامة انتصارنا. ولكن لن نتمكن من قبول هذه الذكريات إلا بالسماح لها بالطفو على سطح الوعي. فحتى وإن كان الوعي بها هو مصدر الشعور بالألم، إلا أنه مكان الشفاء، ففي الوعي يمكن أن نكتشف الأسباب الحقيقية للألم. وإن أردنا أن نساعد شخصاً يتألم يجب ألا نسعى إلى إزالة ألمه بل بالأحرى نقبل أن نبقى بجانبه صابرين ونشاركه مصابه. وهكذا نتعلم أيضاً في ألمنا الشخصي ألا نتخذ موقف النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، بل نقبل أن نصبر على آلامنا ونتحاور معها.
إلقاء اللوم على الآخرين
لا شك في أن الآخرين كانوا في مرات عديدة سبباً لآلامنا، ولا شك أيضاً أننا كنا بدرونا سبب ألم لهم. ولكننا كثيراً ما نمضي وقتنا في إلقاء اللوم على الآخرين، فذلك ينفث عن ضغينتنا وغضبنا، ونتهم الآخرين بأنهم جرحونا وأثاروا غضبنا وندينهم. وما غضبنا إلا وسيلة تحجب جروحنا. ولكن إدانة الآخر قد تحتمل الصواب والخطأ، وقد بكون من المناسب أحياناً أن نقطع علاقة ما لأننا لا يمكننا تحمل الألم الذي تسببه؛ أو أن ضررها يعوق نمونا.
وإذ قبلنا مبدأ إدانة الآخر، علينا أن نواجه أنفسنا أيضاً بشجاعة، وأن نبحث بحثاً أميناً عن مسؤوليتنا عن الحال التي آلت إليه الأمور. فعلينا أن نتساءل إذاً: "عندما اتخذ قراراً بقطع علاقة ما، هل لا زال الآخر يهمني وتعنيني مشاكله؟ هل واجهته منذ بداية المشكلة أم تركت الأمور تتطور إلى أن وصلت إلى حالها الآن؟ لأننا إن لم نواجه أنفسنا بشجاعة يمكن أن "نضحك على أنفسنا" فنقول: "لولا وجودك وحِدّة انتقادك لكنت أكثر ثقة بنفسي!" إن هذه "اللعبة" تعوق نضجنا ونمونا، ولا سبيل لخروجنا منها إلا بالغفران، فالشفاء الوحيد في المصالحة.
نوعان من الغفران
حذار! فهناك نوعان من الغفران: غفران سطحي سهل وغفران حقيقي عميق صعب. وطريق الغفران الحقيقي طويل ومؤلم، ويتطلب منا أن نعود إلى جروحنا فنعيشها مرة ثانية. فإن كان مصدر جرحي هما والدَيَّ لأنهما رفضاني لسبب أو لآخر، فقد أقول في نفسي: "ربما عشتُ طفولة بائسة وصعبة ولكن والدَيّ قد عملا ما بوسعهما وقد غفرتُ لهما". ولكن الحقيقة عكس ذلك، وهذا الغفران شديد الضحالة وتبقى ضغينة عميقة في قلبي تعمل في اللاوعي. وخلافاً لذلك قد أقول في نفسي: "لا، لم يقم والدَيّ بما يجب عليهما تجاهي، كان بوسعهما أن يكونا أفضل من ذلك، لقد أخطآ كثيراً في حقي". وهكذا يبدأ عمل الغفران الحقيقي. والدليل الدامغ على شفائنا فعلاً هو أن ذكرى الأحداث المؤلمة لم تعد تسبب أي ضغينة ولا غضب. ويتم هذا الشفاء عندما نقبل هذه الأحداث والأشخاص المرتبطين بها كجزء لا يتجزأ من حياتنا وعندما نغفر لكل من يحتاجون إلى ذلك.
الخلاصة: دور الإيمان
كم من مرة سمعنا: "كم أود أن أغفر ولكنني لا أستطيع ولا أقدر!" فليس الغفران إحساساً صِرفاً، بل قراراً واختياراً، فهو اختيار غير مشروط ونوع من الحب. إن الغفران هو تخطي للجرح وللضرر الذي تسبب فيه الآخر وهو صلاة لأن يشعر بالسعادة، فمن جَرَح هو شخص مجروح وتعيس. ما أصعب ذلك ولكنه ليس بمستحيل. ويسوع يدعونا إلى أن نحب كما أحبنا وأن نحب أعداءنا ,ان نصلي لمن يضطهدوننا ولا أظن أنه يطلب المستحيل. "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا"، و"أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا". علينا فحسب أن نحمل جروحنا إلى الرب ونطلب إليه أن يشفيها وأن يعلّمنا كيف نغفر.
تدريب
يستخدم هذا التريب الخيال الموجّه ويتخذ مادته من إنجيل يوحنا 13/1 – 17: غسيل الأرجل.
خذ الوقت أولاً للقيام بتدريب للاسترخاء (مثلاً التنفس العميق والتركيز على أعضاء الجسم الواحد فالآخر).
اطلب نعمة أن تعرف كيف تغفر لمن جرحوك لكي تشفى.
تخيل نفسك في الغرفة التي شارك يسوع فيها تلاميذه في العشاء الأخير... تأمل الغرفة، أنظر بعيني المخيلة إلى موقع التلاميذ حول المسيح وماذا يفعل كل منهم... لاحظ أبعاد الغرفة والإضاءة والجو العام...
أنظر إلى المسيح وقد قام وخلع رداءه وأخذ منشفة وائتزر بها، ثم صب ماءً في حوض وشرع يغسل أرجل تلاميذه. راقب يسوع وهو يغسل رجلي كل تلميذ، لاحظ تعبيرات وجهه وحركاته ونظرته وحنانه... ما هو شعورك؟ ما هو رد فعلك أمام ما يفعله يسوع؟ ثم لاحظ أن يهوذا "الذي سيسلمه" ما زال في الغرفة، ويسوع يغسل قدميه وهو يعلم أنه خائن... وبطرس أيضاً موجود، بطرس الذي سينكر المسيح... وقد غسل يسوع قدمي يهوذا وقدمي بطرس بالحب نفسه والحنان نفسه... ما هو شعورك وما هو رد فعلك عندما يغسل يسوع أقدام هذين التلميذين؟ ابق بعض الوقت مع إحساسك لتعمقه في نفسك وتصل إلى أسبابه الدفينة... ثم ضع نفسك بين بطرس ويهوذا، وها هو يسوع يأتي ليغسل قدميك أنت يا من خانه كثيراً... وهو يغسلهما بكل الحب والحنان... وينظر إليك بحب وغفران... ما هو شعورك الآن؟ ما هو رد فعلك؟
بعد ذلك ضع الشخص الذي جرحك وتجد صعوبة في أن تغفر له محل بطرس أو يهوذا، ثم ابدأ في غسل قدميه... ما هو شعورك وما هو رد فعلك؟... إن وجدت صعوبة في القيام بذلك (وهو الوضع الطبيعي!)، دع المسيح يغسل له قدميه بينما تراقبه... ثم بدّل الأدوار: تارة ضع نفسك محل يهوذا والمسيح يغسل قدميك ثم يغسل قدمي الشخص الآخر الذي تود أن تغفر له، وتارة أخر ضع نفسك محل المسيح غاسلاً قدمي الشخص الآخر، وهكذا حتى تجد في نفسك القدرة على غسل قدميه.
وقد يستلزم ذلك التدريب فترة طويلة من الوقت (ربما شهر)... ولكن إن ثابرنا ننجح فيه لأن المسيح قد وعدنا بأنه معنا. وإن شعرنا بضيق وتعب في التدريب، يمكن أن نتوقف ونتحدث إلى المسيح معبّرين له عن مشاعرنا، فهذه المناجاة في غاية الأهمية.