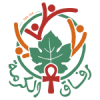بقلم الأب داني يونس اليسوعيّ
عرفت رسالة يسوع في الجليل نجاحًا كبيرًا في بادئ الأمر، إذ كان يعلّم فيعجب الشعب بتعليمه، ويشفي المرضى فيتعزّى الشعب بمعجزاته، ويطرد الشياطين فيعترف الشعب أنّ نبيًّا عظيمًا قد قام في إسرائيل، ولكنّ الأناجيل كلّها تعترف أنّ يسوع في الناصرة اختبر أنّ لا كرامة لنبيّ في وطنه. لماذا؟
لأنّ قوم النبيّ يظنّون أنّهم يعرفونه: أليس ابن النجّار؟ ألا نعرف إخوته وأخواته؟ ألم نشهد طفولته ونموّه؟ من هذا حتّى يكون آتيًا من الربّ؟ نحن نعرف من أين أتى، نحن نعرف من هو! هذا هو الوهم الّذي يقع فيه الناس. يظنّون أنّ ما يأتي من الله هو دائمًا الغريب، البعيد، الخارق، المختلف. ألا ننتظر علامات حضور الله في الخوارق؟ ألا ننسى أن نرى معجزات الله في المألوف، العاديّ، اليوميّ؟ ألا نقول حتّى: الكنيسة القريبة لا تشفي؟ ألا ننسى أن نرى علامات حبّه في نموّنا البطيء، أو حتّى في ضعفنا، كما اختبر مار بولس وأخبرنا عنه في رسالته: "تكفيك نعمتي، ففي الضعف تكتمل قوّتي".
كلّ الرسالة الثانية إلى أهل كورنتوس تهدف إلى أن تزيل الحجاب عن أعيننا، فنرى عمل الله حتّى في قلب صعوباتنا: " على أَنَّ هذا الكَنْزَ نَحمِلُه في آنِيَةٍ مِن خَزَف لِتَكونَ تِلكَ القُدرَةُ الفائِقَةُ لِلهِ لا مِن عِندِنا. يُضَيَّقُ علَينا مِن كُلِّ جِهَةٍ ولا نُحَطَّم، نَقَعُ في المآزِقِ ولا نَعجِزُ عنِ الخُروج مِنها، نُطارَدُ ولا نُدرَك، نُصرَعُ ولا نَهلِك، نَحمِلُ في أَجسادِنا كُلَّ حِينٍ مَوتَ المسيح لِتَظهَرَ في أَجسادِنا حَياةُ المسيحِ أَيضاً. فإِنَّنا نَحنُ الأَحياءَ نُسلَمُ في كُلِّ حينٍ إِلى المَوتِ مِن أَجلِ يسوع لِتَظهَرَ في أَجسادِنا الفانِيَةِ حَياةُ يسوعَ أَيضًا." (2كو4: 7-11).
غير ذلك أن ننظر إلى الآخر نظرة تدعوه أن يعطي أفضل ما عنده، نظرة تنتظر منه أن يكون على مستوى هويّته الحقيقيّة أي أنّه ابنٌ لله. حينذاك نرى كم أنّ الله قريب منّا، قادر على تحويل القلوب، قادر أن يغذّي الألوف بخمسة خبزات وسمكتين، قادر أن يفيض ينابيع مياه حيّة في قلوب من يصدّقه فيروي عالمًا مهدّدًا بالتصحّر.
يسمّي الكتاب المقدّس مأساة الناصرة باسم قساوة القلب. القلب القاسي العنيد هو ما يجعل الإنسان يبحث عن الله حيث لا يوجد: "لمَ تبحثون عن الحيّ بين الأموات؟" لمَ نبحث عن الله في المعجزات والظهورات والخوارق، وهو الحاضر إلى جانبنا في القريب الّذي يكفي أن ننظر إليه على أنّه ابن الله لكي يحمل لنا طاقات الحبّ الّتي نحتاج إليها. فلنطلب إلى الله اليوم أن يشفي قساوة قلوبنا، لكي لا نأسر الناس ولا الله في أحكامنا القاسية والمتحجّرة. فلنكفّ عن أن نطلب الله هنا وهناك، لكي نختبره في واقعنا العاديّ، يحوّل يوميًّا تعبنا إلى خبز، ألمنا إلى مخاض ولادة جديدة، يأسنا إلى رجاء، خطايانا إلى خبرة غفران، ضعفنا إلى اكتمال القوّة.
مأساة أهل الناصرة أنّهم ظنّوا أنّهم يعرفون يسوع، لأنّهم يعرفون من أين أتى، يعرفون عائلته. هذه مأساتنا حين نظنّ أنّنا نعرف الآخرين لأنّنا نعرف منشأهم: نقول هذا نعرفه، ابن فلان، كلّ عائلته كذا، أو هذا نعرفه، إنّه من البلد الفلانيّ وكلّ أهل هذا البلد كذا، أو هذا نعرفه، في الماضي صنع كذا وكذا وهو لن يتغيّر. كلّما مرّة نحكم أنّنا نعرف فلانًا، ونحبسه في تصوّراتنا وفي أحكامنا، نعيد مأساة الناصرة: لا نقدر أن نرى المسيح في القريب حين نجعل من القريب لعبة أحكامنا. حين ننظر بعضنا إلى بعض نظرة تسجن الآخر في تصوّراتنا عنه، نمنعه من أن يكون نفسه ولا نسمح أن يخرج منه ما قد يغيّر حياتنا، وهكذا يسوع نفسه، ما استطاع أن يعطي في الناصرة ما عنده من قدرة شفاء، لأنّ الله يرفض أن يفرض نفسه، وحيث لا ندعه يكون الله، لا يظهر مجده.
نشرت على موقع الآباء اليسوعيين في الشرق الأوسط