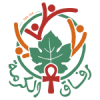بقلم الأب جاك ماسون
في كلّ مرة نشارك بعضنا بعضاً عن الصلاة، يظهر تناقض عجيب: كلّنا نعيش في حضور الله على مدار أيامنا، ولكننا نظل غير قادرين على أمانة في الصلاة الطويلة أو على تأمل شخصي يومي.
لدينا وعي جاد بوجود الله في حياتنا فنحن لا نتكلم عن المستقبل دون أن نظلّله دائماً بـ "إن شاء الله" واعيين ومدركين أن مشيئته دائماً وأبداً في كل مشاريعنا فنحن نتضرع إليه، في كل لحظة، أن يعضّد خططنا ويحقق رغباتنا ويحفظنا من الشرير على مدار اليوم كله. ترتفع قلوبنا وأفكارنا إليه، وعندما تتحقق رغباتنا، نتهلل ببساطة قائلين: "الحمد لله" مدركين أن الله يصنع الأحداث أكثر منا.
إذن من أين تأتى عدم المقدرة على الإطالة في الصلاة وعلى المثابرة فيها وقت طويل، في حين أننا لا نجد أيّ عناء في هذه التضرعات القصيرة والصلوات المقتضبة التي نُصعدها إليه. ما هو الفارق بين الاثنين؟ بين الصلاة القصيرة والصلاة الطويلة؟ ومن أين يأتي هذا التناقض في حياتنا؟
أظن أن سبب ذلك الاختلاف يرجع إلى طبيعة إيماننا طالما أن الصلاة هي التطبيق العملي للإيمان فإيماننا جماعي وسواء كنا مسيحيين أو مسلمين فإننا نشترك سوياً ونتنفس هواءً واحداً وكما ذكرت، فإن إيماننا – قبل كل شيء – ظاهرة اجتماعية خاصة ببلدنا، ونظل اليوم كما قال عنا هيرودوت منذ 1200 سنة: "الشعب الأكثر تديّناً في العالم".
هذه الصفة الجماعية الاجتماعية لإيماننا نعمة كبيرة حقاً فهي تحفظنا معاً في خشية الله كما تحفظنا في محبته. وتعطي معنى واحداً لحياتنا فنحن نعلم "أننا منه وإليه راجعون"، كما تحمينا من ضلالات وتحلّل الحضارة المسماة بالغربية، وتخلق بيننا أواصر الوحدة التي تتعدى كل انقساماتنا من مسيحيين ومسلمين.
لكن هذه الصفة القبلية أو الجماعية لها أيضا عيوبها. فهي تجعل من إيماننا إيماناً سطحياً وتعوقه أن يصبح شخصاً بحق. ولأن إيماننا أولاً هو ظاهرة اجتماعية فهو يعبر عن ذاته بمظاهر اجتماعية أي خارجية، ملابس مميزة للقسوس كما للشيوخ، دق الصلبان على المرافق كسمة نتعارف بها، لحية للمسنين وحجاب للنساء، سباق في الارتفاع بين المآذن ومنارات الكنائس، استخدام الصليب والمصحف معلقاً على الصدور ولكننا في هذا كلّه، لا نجد ما يجعل من الفرد ملتزماً بعمق.
وعلى مستوى التفكير الفردي، فإن إيماننا يؤكد ذاته بالقوة بدلاً من أن يفسّر ما حوله، أو ينقد ذاته من الداخل. لم أجرؤ أبداً أن أسأل مسلماً كيف يستطيع أن يضع ثقته في كلام محمد ولكنني جرؤت كثيراً أن أسأل أخي المسيحي عما يجعله يضع ثقته في يسوع المسيح وأن يؤمن بألوهيته وإنما أخشى أنه في كلتا الحالتين، أن تتلاقى الإجابات إما بتغيير السؤال مؤكدين حقيقة إيمانهم، أو الاعتراف بأني أؤمن لأنهم علموني هكذا. لا توجد إجابات شخصية، وتظلّ المطبوعات الدينية – عامةً – ضعيفة جداً على المستوى الفكري ويتعايش التطوّر في العلوم والتكنولوجيا جنباً إلى جنب مع ثقافة دينية لم تتغير عما كانت عليه من القرن الرابع أو السادس الميلادي ويظل "الدين الاجتماعي" غريباً وبعيداً عن أى فكر نقدي شخصي.
وعلى المستوى الحياتي أيضاً، فالإيمان الجماعي لا يحثّ على الالتزام في الحياة الشخصية. فإني أستطيع أن أدعو الله طوال اليوم، أناديه وأصلي له. ولكني كذّاب على جميع المستويات، وفي كل السنين، غشّاش في الامتحانات في سن السادسة عشر وقبلها وأيضًا غشاش في العمل في الثلاثين وما بعدها، أؤكد بقوة ما لا أعتقده مطلقًا مدركًا أنني لا أغش أحدًا، فمنذ زمنًا طويل لا يصدّق أي شخص ما يؤكده آخر.
كل ذلك يفسّر السهولة التي نشعر بها في أن نصلّي صلاة قصيرة في مقابل عدم مقدرتنا على أن نصلّي طويلاً.
الصلاة القصيرة هي انطلاقة للقلب، ارتقاء نحو الله، هي صرخة وربّما أمنية أو انفعال، تُولَد على سطح ذواتنا وتظلّ عند السطح، فبالتأكيد نحن نؤمن بعمق ولكننا نعيش هذا العمق بطريقة سطحية. الصلاة القصيرة لها قيمتها الأكيدة والحقيقية مثلها مثل الإيمان الجماعي، ولكن كمثل هذا الإيمان لها حدودها.
الصلاة القصيرة تعبّر عن اتحادنا بالله عن إيماننا الذي نشعر به – وذلك غاية فى الجمال – ولكنها لا تغيّر شيئاً في حياتي، فهي تُولَد من شعور أو حدث، من صدمة عابرة، وتذوب مع مرور مسبباتها. هي سريعة الزوال كالمشاعر نحن عاطفيون بشدة في إيماننا كما في حياتنا والصلاة القصيرة تعبّر عن حساسية ورقة الإيمان.
أما الصلاة الطويلة فهي تأمّل يتوجه إلى عمق النفس، هي بحث عن وجه الله وعن أسلوب عمله داخل خليقته، هي تعليم عمَّن هو الله. الصلاة الطويلة هي أيضا تأمل في حياتي وتمييز للنداءات التي يوجّهها الله لي من خلال أحداث عمري الصلاة الطويلة مفيدة لأنها هي التي تغيّر نظرتي للأشياء في ضوء الإنجيل الذي أتأمّل فيه. الصلاة الطويلة تغيّرني وتهديني لأنها مراجعة للحياة وتخطيط للغد ومشروعاته في نور الله فمن خلال الصلاة الطويلة يتحوّل تعبيري عن إيماني فيصبح ناضجاً وشخصياً. كذلك في الصلاة الطويلة أبنى حياتي متوافقة مع إيماني لأنه من خلالها تنضج قراراتي واختياراتي.
ولكن هذا كلّه غير مؤكد فليس هناك شيء بسيط في هذا العالم. وإذا كانت للصلاة القصيرة حدودها فالصلاة الطويلة لا تخلو من الغموض.
فمن منا لم يقابل – على الأقل مرة في حياته – هؤلاء الفاشلين إنسانيا.. المضطربين عصبياً.. العاجزين أو ببساطة هؤلاء المنبوذين من المجتمع، من لا يجدون من يحبهم، كل هؤلاء يبحثون عن ملجأ في الدين ويجدون في الله "الوحيد" الذي يسمعهم ويفهمهم، ويصنعون من صلواتهم الطويلة ذريعة لكيلا يواجهوا الحياة الصعبة.
فلو كانت الصلاة الطويلة مهرباً من عالم شديد العدوانية، فهي خطر حقيقي، ويمكن أن نتساءل عما إذا كانت بعض مجموعات الصلاة المزدهرة حولنا ليست في الواقع أكثر من ملاجئ جماعية لغير القادرين على التعامل مع مجتمع حيث التنافس على أشدّه، مجتمع يُستبعد فيه الضعفاء. أتساءل أيضاً إن لم تكن هذه المجموعات فرصة مواتية لهروب أقلية مرفوضة من "مجتمع أغلبية يطحنهم".
ألا يجب أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى التزاماتنا الدينية تخفي وراءها خوفاً من مواجهة المشكلات الحقيقية أو خوفاً من الاندماج في المجتمع ؟ نحن نصلّي من أجل العدالة في العالم لأننا نخشى الخوض في أوساط العمل حيث يجب تحقيق هذه العدالة، ونصلّي أيضا للسلام لأننا نخشى من اللكمات إذا حاولنا أن نفصل بين المتعاركين – الصلاة الطويلة لا تفيد إلا إذا ما ساعدت فعلاً على الالتزام ولكننا للأسف نستطيع أن نغش في الصلاة كما نغش في الحياة. ومن حسنات مواجهة الحياة أنها تُظهر وتفضح هذا الغش وهذا الكذب الذين يوشكون على الانزلاق والتغلغل في صلاتنا.
ويبقى صحيحاً أن الصلاة الطويلة في جوهرها تظلّ اختباراً وتعميقاً للإيمان، وإعطاء طابع إنساني له كما أنها تجعل من الحياة إنجيلاً معاشاً.
في الصلاة الطويلة يتردّد سؤال المسيح في أعماقنا:
أما أنت، فماذا تقول عني؟
الخاتمة
بعض النصائح العملية لأننا لا يجب أن ننسى أننا من خلال هذه الأفكار نبحث عن الطريقة التي نستطيع بها أن نصلّي. أن نصلّي حقيقةً.
- نحن لا نصلّي لنريح ضميرنا، لا نصلّي لأنفسنا لكننا نصلّي لله بدون مقابل.
- الصلاة ليست فرضاً وواجباً بل هي فعل حبّ، وإنه لبشع أن نحوّل الحبّ إلى واجب، فالصلاة تحتاج إلى خفة ومجانية وتلقائية الحبّ.
- إنها مثل الحب لا تنجح، إذا عشناها على أهواء الرغبات والنزوات. فالصلاة شأنها شأن الحبّ تتطلب الوفاء: وفاء في وقت محدد منتظم. يجب أن نعطيها إيقاعاً. في قصة "الأمير الصغير" لسانت اكزوبيريه، يقول الأمير الصغير: "إذا أردت أن تصير صديقي، عليك أن تأتي كل يوم في نفس الساعة".
علينا أن نتعلم أن نلتزم في الصلاة بكامل كياننا وليس نصفه فقط، لاحظوا إذن الطريقة التي بها تدخلون في الصلاة لأن الوقت الذي اخترناه لها قد حان، هذا الدخول في الصلاة هو فعل إيمان ذو ثلاثة أبعاد:
إيمان عملي:
فأنا أفعل شيئا: أضع نفسي في حضرة الله
إيمان شخصي:
فأنا الذي أقوم بالفعل – هو قراري إذن، وهو قرار يلزمني ويضعني في علاقة مع الله.
إيمان لاهوتي:
أقصد بذلك أنني أعي أن الاتصال الذي أبدأه مع الله بقراري وفعلي من ناحية – هو في حقيقة الأمر هبة من الله. فهو الذي يبدأ الاتصال حقيقة ويعطي نفسه في فعل صلاتي.
- ولكن بالرغم من كل ما قيل فلا يجب أن أفهم صلاتي وكأنها خارج حياتي وكأنما لكي أصلّي يجب أن أترك كل ما أصنعه على مدار يومي جانباً. لا فصلاتي هي إرجاع لحياتي في يدّي الله. كم من الصلوات كانت بلا ثمر لأنني بدلاً من الانطلاق من حياتي، انطلقت من نص. وأظن أن أي نص لا علاقة له بما أعيشه في هذا الوقت، – حتى أفضلها وأجملها (كلمة الله) –سيكون بلا ثمر لأنني أحاول جاهدًا أن أطبّق النص على حياتي، وبذلك أقلب الوضع: فحياتي هي التي يجب أن أطبّقها على النص.
- بعد الاحتياط السابق، ملاحظة الأخيرة: نحن لا نعرف أن نصلّي! وهذا كلام الله نفسه، فالروح القدس هو الذي يأتي ليساعد ضعفنا (رومية 8). ودورنا في الصلاة هو مدّ هذه الأذرع التي لا تستطيع أن تصل قط لمن تريد احتضانه، فالاتحاد بالله فهو هبة الله.